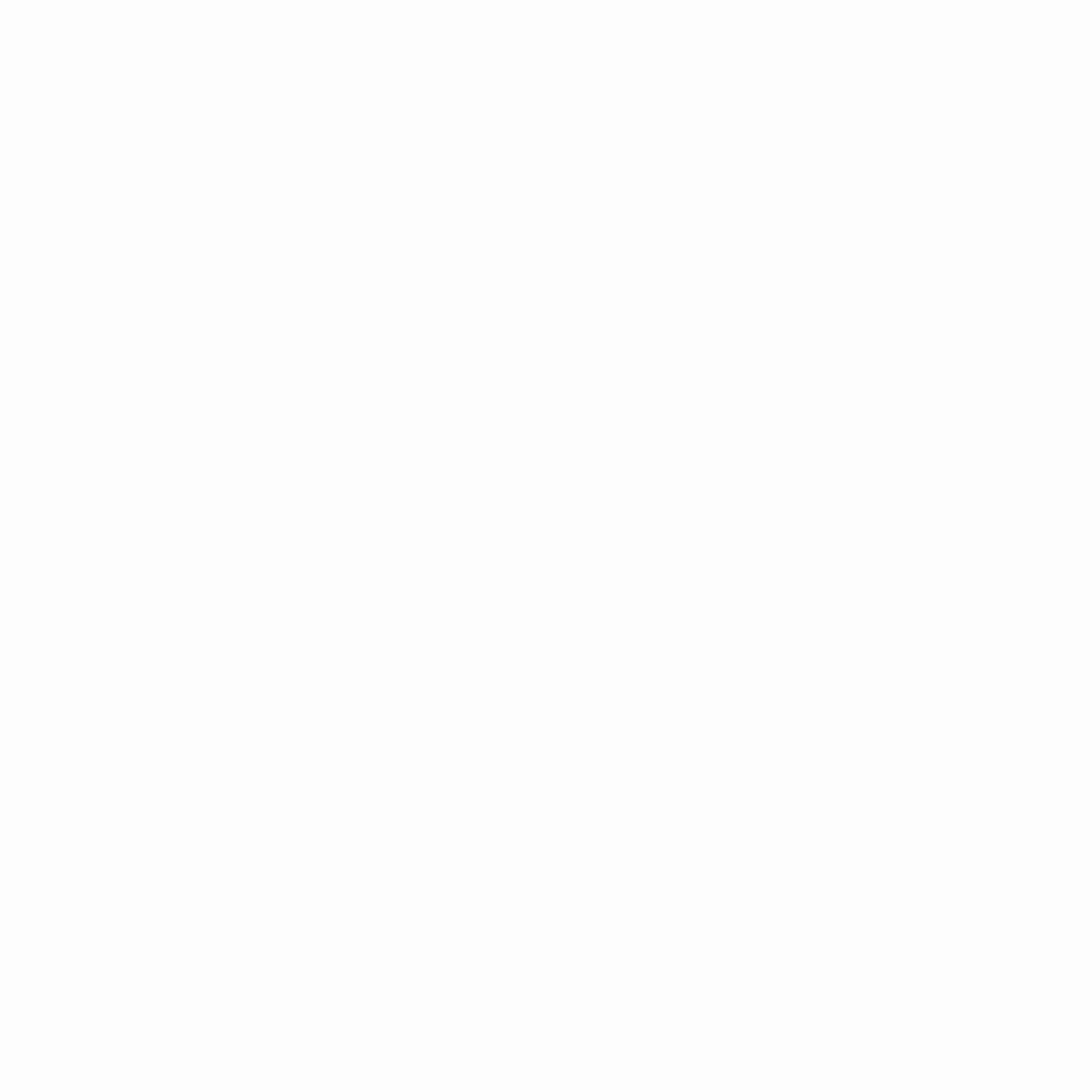آندرو روبينسون*
ترجمة: حصة السنان
كتب ماركوزه كتابه: (الإنسان ذو البعد الواحد)[1] في عام 1962، ولكنه في كثير مما جاء فيه كأنما قد كُتب اليوم: تسطيح الخطاب، والكبت المتفشي وراء ستار من “الإجماع”، وعدم الاعتراف بمنظورات وبدائل تتجاوز الإطار المسيطر، وانغلاق عالم المعنى[2] المسيطر، والتلاشي في الحريات المقرَرة ومنافذ الهرب، والتعبئة الكاملة ضد عدو دائم جُعِل من صميم النظام ليكون أساساً للموافقة المصطنعة (conformity)، والجهد المبذول.. لقد كان الكتاب منتوج حقبة نكوص سابقة، شبيهة في كثير من جوانبها بما نعيشه الآن.
يكمن الاختلاف الأكبر، عن الوضع الحاضر، في أنه، على خلاف ثلاثين عاماً من النيوليبرالية والموجات الأخيرة من التراجع الاقتصادي، كان ماركوزه يكتب في وقت كانت فيه دولة الرفاه تنمو، ويصير فيه حال عامة الناس أكثر يساراً. هذا يعطي معنى مغايراً لعناصر الكبت في السياق. كان ماركوزه يعطي انطباعاً عن أناس قد ركنوا إلى السير مع التيار، لا مرغمين ولا مخدوعين.
“البعد الواحد” في العنوان، يحيل إلى تسطيح الخطاب، والمخيلة (imagination)، والثقافة والسياسة داخل مجال الفهم والرؤية الخاصة بالنظام المسيطر. يعقد ماركوزه مقابلة بين المجتمع المستهلك الموسر في الرأسمالية المنظمة، وبين وضعٍ سابق شهد وجود إنسان “ذي بُعدَين”. وُجد هذان البُعدان في عدة مستويات، ولكنهما بالنسبة لماركوزه يعبران عن جانب واحد: تعايش النظام الحالي مع ما ينقضه.
في الثقافة، عُيِّر عن هذا البعد الثاني بدور الثقافة بما هي نقد، بحيث تكون، حتى الجوانب المحافظة للثقافة، تتعارض مع النظام السائد، تقدّم شخصيات (من مِثْل: بطلات المآسي وأبطالها) على أنها مِن المحبطين في عالم اليوم، ويظهر أيضاً هذا البعد الثاني في وجود مجال حي لثقافة راديكالية.
في الفكر، ظهرت الفجوة بسبب المسافة بين مفاهيم معينة واستعمالاتها المخصوصة، وبسبب احتمالية الفصلِ -على مستوى المفهوم- بين فاعلٍ (عامِل) أو شيء (موظف، شيء منتَج) عن سياقه الوظيفي أو النظامي (العمل، السلع)، وبسبب التعارض بين القيم الأخلاقية، والواقع المعيش.
الفجوة بين البعدين، فيما يرى ماركوزه، هي أمر جوهري في احتمالية التغيّر الاجتماعي. تفصل الفجوة ما هو ممكن عما هو واقع وحاضر، ما يجعل تصوَر أوضاع مختلفة جذرياً عن النظام الحالي أمراً ممكناً. القضاء على الفجوة يجعل التفكير فيما هو خارج عن إطار النظام أمراً مستحيلاً، وهذا يجعل التفكير في بدائل تتجاوز تكرار العلائق الاجتماعية القائمة أمراً مستحيلاً. ينتج البُعدان فسحة أو مسافة بين ما يمكن التفكير به وما هو موجود؛ فسحة يمكن للفكر النقدي أن يزهر فيها. كما أنهما يعتمدان على “ضمير تعيس”، منفصل عن الواقع الحاضر، وعلى وعي بمشكلاته في بعض مستوياتها.
وحسبما يرى ماركوزه، سُدّت هذه الفجوة بإجراءٍ يكاد أن يكون إدماجاً اجتماعياً شمولياً، من خلال تنسيق الوظائف الاجتماعية وظهور النزعة الاستهلاكية والفكر الإداري (الحكومي). صوّر ماركوزه هذا الإجراء بأنه يجري بعدة سبل، أحدها أن ثقافة الاستهلاك تتسلل إلى حيوات الناس وعوالمهم المعيشة، وأن الرأي العام يتدخل في المجال الخاص: رؤية النظام تدخل إلى البيت عن طريق التلفزيون، والراديو، والبضائع المستهلَكة؛ كما تدخل إلى المجتمعات من خلال عناوين أخبار ليس منها مناص، تُنشَر خارج نطاق الصحف، وهيمنة “الرأي العام”، وتدخلات موظفي الدولة.
أظن أن ماركوزه محق في أن إبقاء مسافة تحفظنا من التسليم الاجتماعي ضروري من أجل أن تتشكل تصورات ورؤى مهمة وذات قيمة، ولطالما كان عدم الوعي بهذا البعد يدفن محاولات يسارية لتشكيل السياسة.
انظر، على سبيل المثال، في اللوحات (البوسترات) المنتشرة في كل مكان في نوتنجهام -المملكة المتحدة- تروج لإجراءات فرض النظام المستحدثة، وتزود بأرقام مخصصة لـ “الدعم” المقدم من بلدية المدينة، للتعامل مع المشاكل المحلية بأساليب قمعية (بلِّغ عن “لص”، بلّغ عن “سلوك معادٍ للمجتمع”، كاميرا المراقبة موجودة هنا “من أجل سلامتك”، هذا وذاك من أعداء الشعب قد منعوا من دخول هذه المنطقة بسبب تسولهم، أو بسبب سرقة زهيدة، أو لكونهم فقراء عموماً…إلخ). لا يكاد المرء أن يسير في الطرقات اليوم دون أن يقر بصمتٍ أو أن تخيفه رسائل كهذه. هل تختلف حقاً حملات التدمير هذه عن حملات دعاية الحروب الصليبية في شموليتها الكلاسيكية؟ وهل من مصادفة في أن تدخلاً موغِلاً كهذا يتزامن مع حملات على البوسترات التي تُعلّق في الشوارع خفية من الشرطة أو بلا ترخيص، ومع حملات الكتابة على الجدران، وبل وحتى مع فرض حظر يمنع ملصقات الانتخابات على أعمدة الإنارة.
علاوة على ذلك، فإن الناس أنفسهم قد “أُخضِعوا “لموافقة النظام والإقرار به. الموافقة تتولد من التكرار والعادة، مع أناس، راكنين إلى حالة من التنويم المغناطيسي بوتيرة مطرّدة من العمل في المصانع، والاستهلاك الجماهيري. هذا يذكّرنا بمناقشة باثس عن الموضة: يخلق النظام نوعاً من النشوة في تكراره للتنوع ضمن نطاق مغلق. الحاجات قد اصطُنِعَت ووُجِّهَت على نحو يُمكِّن من إرضائها بوسائل وُضِعَت بطريقة ممنهجة (هذه الدعوى قد شكلت فيما بعد الأساس لتحليل إيفان إليتش للتعليم المدرسي).
إن الإدماج الممنهج أو السيطرة الاجتماعية مؤسَّسة اليوم على تلبية الحاجات، بدلاً من إحباطها، الخدعة هنا كامنة في أن الحاجة التي تُلبّى هي ذاتها التي تُختَلق. كان بوسع ماركوزه أن يذكر أيضاً الطرق التي أدت بالعمل والعائلة والاستهلاك إلى أن يلتهموا ما تبقى من ساعات اليوم، حتى لا يبقى للناس وقت للنظر في أحوالهم، أو لأنشطتهم الإبداعية، أو للتنويع في أساليبهم في الحياة، أو لتواصل اجتماعي “خالص”، وهو، ببساطة -كما عبر عنه حاكم باي[3]-: إيجاد الوقت لمجموعة ما لتجتمع، دونما ارتباط بعمل، إذ الاستهلاك، أو العائلة، هي أصلاً مهمة صعبة، وفعلُ مقاوَمة.
وحسبما يرى ماركوزه، فإن آليات الإدماج المختلفة تؤدي إلى نوع جديد من انغلاق اجتماعي يحجب حتى أي منافذ هرب أو انعتاقات متخيَلة. فقدان الفجوة المهمة ينتج “ضميراً سعيداً” يقبل بمعايير النظام، غير أن هذه السعادة ليست إلا سطحية.
ومن جانب آخر يرى ماركوزه أنه، بينما تُلبّى حاجات الناس الأساسية، ثمَّة خوف كامن، وقلق، وعدائية ليست عن السطح ببعيد، وهذه ذاتها توظَف و تستخدم من قِبَل النظام.
في الثقافة، حُيّد البعد الثاني من خلال سلب ما للثقافة “الرفيعة” من قَدر، وذلك بتحويلها إلى ثقافة “جماهير”. الواقع الحاصل في أن الموسيقا صارت تشغّل لتُسمع في ضجيج محلات السوبرماركت، وأن كلاسيكيات الأدب العالمي، تشترى بثمن زهيد في محلات الزوايا. هذا الاختزال المُركَّب يقلل من المسافة بين ما هو ثقافي وما هو من الواقع المعيش، بجعلها مادة تستخدمها الدعايات والنزعة الاستهلاكية.
في الآونة الأخيرة، قد نفكر، على سبيل المثال، كيف أن موسيقا الاحتجاج، بما فيها: البانك، الراب، وغيرهما، ترِدُ، في نسخة منقحة تنقيحاً مناسباً، في قائمة الأغاني الأكثر رواجاً، وفي البرنامج العام للإذاعة الرئيسة، مختَزَلة قيمتها بما تحققه من مبيعاتٍ كسلعة. أو لعل أحدنا يفكر فيما قد لحق النصوص “الكلاسيكية” القيّمة من خسارة، كنصوص ماركس، أو دولوز، أو سارتر (أو، حتى، ماركوزه نفسه)، نتيجةً لمعاملتها كمادة تعليم في الفصول الدراسية، أو مادة للتقييم بالاختبارات: بدلاً من أن تكون على صلة بحياة المرء، أو حتى بدلاً من أن تعتبر بأنها غير ذات صلة بحياة المرء لأسباب وجيهة، فإن هذه النصوص قد نُئِيَ بها وحُصِرت في مجال مركّب تركيباً بينيوياً يظهرها بأنها لا علاقة لها بحياة الفرد.
وفي الوقت نفسه، فإن أولئك الذين ليسوا بطلبة ولا أكاديميين، لا يقرؤون هذه الأمور، إما لأن قراءتها نوع من الدراسة، وبالتالي فهي عمل، يجدر تجنبه إن كان لا يجدي مالاً، أو لأن هذه النصوص قد عُرِّفت بأنها “نظرية”، بمعنى “صعبة”، ولذلك فهي للطلبة والدارسين وحدهم. أولئك الذين كانت لهم قراءات في مثل هذه الأمور، قد ينصرف الناس عنهم لكونهم يعيدون إنتاج ما ليس بذي صلة بحياة معظم الناس، لأنهم قد صُرِفوا إلى مجال من الدراسة قد اعتبر سلفاً بأنه غير ذي صلة بحياة الناس. وعلى هذه الحال، فهذه النصوص في العموم لا تصل إلى من يقرؤها من الطلبة، ولا إلى من لا يقرؤها من عموم الناس، وتضيع أهميتها (الكامنة في قوة تأثيرها)، على الرغم من أن هذه النصوص مسموح بها، ومتاحة على نطاق واسع، وفي كثير من الأحيان متاحة على شبكة الإنترنت مجاناً.
أما في الفكر، فإن ظهور تحليلات متنوعة: وضعية، ووظيفية، وإجرائية يقيد الفكر ويحصره فيما هو واقع. وحده ما يمكن أن يُرى على أنه موجود يتمتع بحقه في أن يكون له وجود في اللغة، ونتيجة لهذا، فالماضي والمستقبل أزمنة مستبعدة في اللغة، بينما يراد للأسماء أن تكون هي السائدة على الأفعال، وصيغ الوصف على صيغ الفعل (على سبيل المثال: تفضيل صيغة “العولمة” كحدث مجرد من الزمان، على الصيغة المعبرة عن ممارسات معينة في “الفضاءات المتعولمة” أو التي تتعولَم). كما أن الأسماء مرتبطة بوظائف مخصوصة، وعليه فإن تصور شيء (مسمّى) مجرداً من وظيفته المرتبطة باسمه يصبح أمراً غير ممكن (على سبيل المثال: كلمة “الديمقراطية” تُفهَم على أنها كلمة تحيل إلى ممارسات قائمة في أنظمة الحكم الغربية، بدلاً من إحالتها إلى نموذج منشود للحكم الذاتي، الذي تدّعي هذه الأنظمة تحقيقه في واقعها).
ولهذا، فالاستعمال اللغوي يصبح كمنوِّم مغناطيسي، أو أنه يُختزَل ليُحوّل إلى مجرد فعل أمر لا يمكن رده (انظر، على سبيل المثال، إلى العبارات الترويجية والمقولات السياسية المروّجة في الدعايات). وبينما مصطلحات مثل “وظيفي”، و”إجرائي” تعتبر موضة قديمة، فإن طريقة التفكير هذه، التي تعبر عنها هذه المصطلحات، ما تزال مهيمنة في الاتجاهات السائدة في العلوم الاجتماعية وفي لغة الخطابة في السياسة وفي الأعمال التجارية.
وقد يصح لنا اليوم أن نأخذ مثالاً كـ”العلاج المعرفي السلوكي”، والذي يسعى إلى التقليل من حالة عدم الرضا عن أنماط الفكر التقويضية، والتي يُشجّع “المريض” أو يدرَّب على تجنبها، لأن أفكار الناس إنما تعني بأنهم عاجزون عن تحقيق أهداف حياتهم. وبدلاً من يستخدم واقع: أن الناس تعساء، كاتهام للنظام، فإن اللائمة، في تعاسة الناس، تُلقى على مقدرتهم الذاتية على التفكير التفكيكي، ويُستهدَف استبعاد أنماط التفكير هذه؛ المنهجُ الذي يستدعي في ذاكرتنا الطريقة الأورويلية في غسيل الدماغ.
إضافة إلى ذلك، قُيِّد ما هو عقلاني وما هو واقعي في الطبيعة الأداتية المحضة للعقلانية التقنية، بما هي عملية حساب محضة، حيث الوسيلة، مقيّدة في حدود ما يقبل الملاحظة والرصد. وبهذا يكون من المستحيل نفي النظام -أي القول بخطئه أو بأنه غير عقلاني- في لغة معترف بها على نطاق واسع. ذلك لأن لغة الحياة اليومية قد نُقِّحَت على نحو دائماً ما يجعلها تحيل إلى الوظائف داخل النظام. حاول أن تجادل من يدعم رأياً وسيطاً يقول بأن بريطانيا ليست حرة أو ديمقراطية، وسيواجهك هذا التأثير: إما أن تكون الديمقراطية كمّية (تقاس بالكم)، وبذلك فهي تقاس بالرتبة التي حققتها بريطانيا في بعض المؤشرات القياسية، التي هي أفضل، قل مثلاً، من رتبة زيمبابوي. أو أنها تُحدد منهجياً باعتبار الاعتراف الرسمي بحقوق معينة، أو بغيرهما من المعايير ما يعتبر بأنه مستحيل أو لم يوجد أبداً، ومع ذلك، لا يمكن إدانة بريطانيا بعدم وجود هذه المفاهيم والتي لا تحمل معنى أو تشير إلى مدلول.
هذا يسكت أصوات “العقلانيات الأخرى”؛ فالحقيقة الواقعية، على سبيل المثال، هي أن الناس لا يستطيعون أن يحتجوا بدون أن تقمعهم الشرطة؛ وأن طالبي اللجوء السياسي، و”المشتبه بهم” خطأً في تهم الإرهاب، هم عرضة لمداهمات الفجر المرعبة، وأن جميع أنواع الممارسات التي لا تسبب ضرراً لأحد (اعتمار قبعة أو ارتداء سروال فضفاض، الاجتماع بأصدقاء، توزيع منشورات، قيادة دراجة…إلخ) يمكن منعها تعسفياً بأوامر صادرة تحت بند تفويض الدولة باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات. هذه كلها تصبح أموراً غير ذات صلة بمسألة ما إذا كانت بريطانيا “حرة” أو “ديمقراطية”. ومن يبني استنتاجات منطقية لما تؤدي إليه هذه الانتهاكات، يُعتبر أنه يعيش في عالم خيالي. ولذا، فالمرء يتعامل مع إجراءات مفرَّغة من معناها، يُبرّرها النظامُ بأنها نتيجة لواقع موجود يلزم التعامل معه بهذه الإجراءات، وتقتصر هذه الإجراءات على المعايير التي يمكن ملاحظتها، وحدها، ثم تنجح بهذه المعايير.
يستخدم ماركوزه مثال إجراءات الرد على تظلمات العمال في المصانع: في ردها على الشكوى، تؤكد الإدارة على أن الشكاوى المقدمة يجب أن تكون أكثر تحديداً، فشكوى مثل “الأجور منخفضة جداً”، تقدم في صيغة أكثر تحديداً في صورة شكوى فردية، مثل أن عاملاً معيناً لا يستطيع دفع نفقات الرعاية الصحية. ومتى ما حُددت هذه المطالبات، صار من الممكن الاستجابة لها مجتمعةً من خلال إصلاحات صغيرة.
يعتقد ماركوزه بأن هذا يستر المنازعات الأساسية الكامنة، ذلك أن الشكوى من أن “الأجور منخفضة جداً”، هي في الواقع شكوى تجمع بين مكوّنين: الوضع الخاص للعامل، وتظلم عام ضد نظام الأجور الذي يحيل ضمنياً إلى حال العمال كلهم و لا يمكن تعديله إلا من خلال تغيير كلي للنظام القائم.
وبتجزئة المكوّن الأول، وتلبيته، وحصر مجمل التظلمات في هذا المكوّن، يُسكِت النظام المطالبات بالمكوّن الثاني، ويجعلها تبدو مطالبات غير منطقية وغير معقولة.
ثمة جانب نفسي أيضاً، يحيل ماركوزه إلى الوضع القائم بـوصفه “الاتضاع/التفكك المنظم” (repressive desublimation). وهو مصطلح في التحليل النفسي يشير إلى حالة دفاعية، تستخدم للتعامل من الرغبات التي كُبِحَت، ولذا فهي حالة لاواعية. غالباً ما تعود للتجلي في أشكال “متعالية”، تتيح منطلقاً لإبداع ثقافي. في منهج فرويد، هذا قد يعني، على سبيل المثال، أن شخصاً لديه حالة عقدة فموية (oral fixation) قد يصبح خطيباً مفوهاً أو مغنياً ماهراً.
عند ماركوزه، كبحٌ كهذا يمكن أيضاً أن يؤثر على الرغبات السياسية: رغبة التحرر التي لا يتاح لها التعبير بشكل واع (سواء باعتبارها محظوراً اجتماعياً، أو لعدم وجود لغة مناسبة)، يمكنها أن تجد سبيلاً لتعبير غير مباشر في مجالات مثل الفن.
يحاجج ماركوزه في أن السيرورة المعاصرة، بطبيعتها المخصوصة -سيرورة تلبية حاجات مخصوصة في مجتمع استهلاكي-، من خلال وسائل ممنهجة هي سيرورة تؤدي إلى القضاء على التسامي: الرغبات “تُسَيَّل”، يتأتى لها تعبير في السياق الاجتماعي، غير أنه تعبير اتضاعي، يسلب ما في المطالبة من معنى يتجاوز خصوصيتها: التطلع الأوسع إلى الحرية.
يراودني شك، هنا، في أن ماركوزه يبالغ. الكبح النفسي في بعض المجالات، وخصوصاً فيما له صلة بصور التعبير عن الغضب، ما يزال شائعاً جداً، والأسرة التقليدية لا زالت حية وفي عافية، بشكلها المباشر، وفي صورتها “الليبرالية” المخففة.
إضافة إلى ذلك، ثمة طرق كثيرة يمارس بها النظام إحباط الرغبات، حتى على مستوى الحاجات الأولية الأساسية ، مثل العجز عن توفير سكن يحقق الكفاية.
غير أن ماركوزه قد قدّم تنظيراً، لجانب من الوضع القائم، قد يصح أحياناً :اللوائح التنظيمية اليوم تنحو إلى تفكيك الرغبات، تاركة مساحة صلبة أقل للاوعي ليعمل بها.
التأثيرات السياسية للرؤية التي يقدمها ماركوزه (أي لدور هذه العناصر وعلاقاتها معاً)، تشير إلى الحاجة لصور من المقاومة التي ترفض مبدئياً النظام المسيطر، فيما تظل متشائمة حول إمكانية هذه الاحتمالات. يؤكد ماركوزه على أن الديمقراطيات الغربية ليست ديمقراطية في الواقع، لأن الناس قد مُنعوا بهدوءٍ من ممارسة التفكير النقدي، وقد وُجِّهوا إلى ما تبقى من الخيارات، على كل حال، داخل دائرة النظام. وهذا، إذاً هو نتاج التلاعب الهادئ، وبما أنه من صميم نظام اجتماعي سلطوي في بنيته الأساسية ، فهو لا يؤسس لأي مطالب بشرعية قانونية.
وعلى مستوىً أكثر تنظيراً، يحاجج ماركوزه أيضاً بأن الحاجات السائدة لا يمكن أن توفر أساساً متعالياً للشرعية، إذ أن الناقد للنظام، ينتقد أيضاً ما ينتجه النظام من حاجات في السياق الاجتماعي، يملك هذا النظام وسائل مختلفة لإدارة المعارضة بحيث يمكنه الإبقاء على إحكام سلطويّ. “الاتضاع بالقبول”[4] (repressive tolerance)، على سبيل المثال، هو ممارسة إنما يُسمح من خلالها للرؤى والتوجهات المعارضة بعد تحويلها إلى “آراء”، تعتنق كما لو أنها ممتلكات (أو أمتعة) شخصية للأفراد، “آراء” تحق للفرد، لكن ليس لها قوة التأثير على الآخرين، وليس على أحد إلزامٌ بأن يأخذها بعين الاعتبار، أي بوصفها معتقدات صادقة (حقيقية)، لا يحق للمعارضة أن تأخذها إلى حيز العمل.
إن اختزال ما يمكن إثبات صدقه من المعتقدات التي يُجزم بصدقها، وذلك بتحويلها إلى “آراء”، يذهب بكل ما يدفع لإيلاء عناية خاصة بتلك الأفكار أوالمعتقدات، أو الاعتراف بمقولات معينة كمعتقدات (ليس بالضرورة بالمعنى الديني) لها قوة الإقرار وتمثل عقيدة سائدة في المجتمع، وبذا؛ يمكن تجاوز هذه المعتقدات وأن لا يُلقي لها بالاً كأنما هي شؤون شخصية، وإن ارتُكبت أي محاولة لأخذ هذه المعتقدات إلى حيز الممارسة، كأنما هي إلزامات غير معقلنة لوجهات نظر شخصية. وبينما يستخدم هذا النوع من الحجج لنقض فكرة ماركوزه باعتباره سلطوياً ناشئاً، فإنه يحسن فهمها على أنها تكشف حدود “الديمقراطية” في السياق السلطوي، كما تكشف الحاجة إلى مشاركة متواصلة فاعلة، تكون أساساً لممارسات اجتماعية تستوعب شتى الجوانب والاختلافات.
أحد جوانب محدودية رؤية ماركوزه واضح جلي؛ (الإنسان ذو البعد الواحد) قد كُتِب قبيل موجة النضال والاحتجاجات الراديكالية في الستينيات، والتي كادت أن تهز أركان النظام السائد، وقد يكون هذا حدٌّ قد جعل هذا العمل (الكتاب) يخفق في التنبؤ بهذه القطيعة، على أن أحداثاً كهذه دائماً ما تأتي على غير تَنبُّؤ، ومن مصادر غير متوقَعة. من وجهة نظري، قد أخطأ ماركوزه في هذا لأنه لم يُوْلِ اهتماماً كافياً للجماعات المهمشة، في أمريكا كما في جميع أنحاء العالم.
إن الدمج (incorporation) الذي ناقَشه ماركوزه قد أثّر بشكل أساسي على الطبقة العاملة المنظمة، التي ينظر إليها ماركوزه، بوصفه ماركسياً، بوصفها العامل الأساس في التغيير الاجتماعي. ولعله لو أنه قد أولى عناية أكبر، على سبيل المثال، للنضالات الناشئة، في معظم أنحاء العالم، لإنهاء الاستعمار، ولظهور الحركات الاحتجاجية بين الأمريكيين الأفارقة، لبدت قيود الانغلاق المنهجي أكثر وضوحاً. وقد يكون ماركوزه قد بالغ أيضاً في تقديره للمدى الذي يمكن به لعالم المعنى التابع للنظام أن يمنع انعتاقاً متخَيلاً أو حركات راديكالية.
ومن المؤكد أن ذلك يغيّر في البنية، فما كان ينظر إليها على أنها “جوانب خارجية” لم تعد تعتبر كذلك، لأنه لم يعد ممكناً أن يكون لها وجود داخل الإطار المسيطر، وللسبب ذاته، يكون خروجها عن النظام أكثر وضوحاً وحدّة بالضرورة. يغّير هذا شكل الرفض، لا احتمالية الرفض. وبهذا الاعتبار، كان يمكن لماركوزه أن يستفيد، مثلاً، من منهج كمثل نهج نغري في تنظير العلاقة الدورية (cyclical relationship) بين انتفاضات المقاومة والسيرورة الجديدة للسيطرة.
كان الدمج استجابة لنوع خاص من إنشاءات المقاومة؛ فهو لم يمنع احتمالية وجود مقاومة من هذا النوع، وعلينا أن نجعل هذا في اعتبارنا إذا ما نظرنا لحالة التراجع والنكوص التي نشهدها. أمر آخر، أرى أنه يحد من رؤية ماركوزه، هو موقفه الراسخ من التقدمية [باعتباره صاحب موقف ثابت وراسخ من دعم التقدمية]: على الرغم من نقده الرصين للعقلانية التكنولوجية، فهو ما انفك يراها في الأساس تقدمية، كما في تعبيره عن انتصار البشرية في نضالها في وجه “حتمية” الطبيعة، وتلك وجهة نظر تبدو متهافتة في ضوء نقده الانتقادات، اللاحقة، المستندة على وجهات نظر بيئية.
تأكيد ماركوزه على الفردانية والخصوصية أساساً للفكر السلبي، هو، أيضاً، محل جدل، بلا شك. ذلك أنه مبنيٌ على وجهة النظر القائلة بأن فضاءات مخصوصة في حِقَبٍ سابقة في الرأسمالية قد وفّرت مجالاً يمكّن لإصدار أحكام ذاتية (انطباعية) مستقلة، وهي وجهة نظر قد تكون محل نظر عند غيره من المنظرين. هناك في النسوية، على سبيل المثال، من يناقش مسألة إذا ما كان البيت حقاً مكاناً خاصاً، جاعلاً حجته على ذلك في أن البيت يجسد ديناميكيات الجندر، (أي: سيرورة التدافع في العلاقة بين الذكر والأنثى)، التي تتجلى في البنية الاجتماعية الأوسع، وقد هيأ لهذه الديناميكات موقعاً -هو البيت- للعمل المنزلي، حتى قبل أن تأتي الثقافة الاستهلاكية زائدة على هذه الحال.
لقد كان ماركوزه مدركاً، وكثيراً ما يورد إثباتات، بأن “الفجوة” القديمة كانت محصورة في كونها منتوجاً للأفضلية. ومع إقراري بمشكلات كهذه، فإني أعتقد بأنه من الأهمية بمكان أن نحافظ على فكرة وجود مسافة لازمة، تكون أساساً للانعتاق من التسليم. أظن أن ماركوزه محق في أن إبقاء مسافة تحفظنا من التسليم الاجتماعي ضروري من أجل أن تتشكل تصورات ورؤى مهمة وذات قيمة، ولطالما كان عدم الوعي بهذا البعد يدفن محاولات يسارية لتشكيل السياسة.
وليس مدار القول هنا على أن ما هو خاص هو مساحة لا تُمَس، إذ إن اختلاق مساحات تتجاوز المجال الاجتماعي المسيطر، ضروري للانعتاق من ضغوط نفسية وجدالية يواجهها المرء إذ يراد دفعه إلى الموافقة (conformity). وللتأكيد، فإن مثل هذا الهروب لا يضمن بأن لا يكون المرء تحت وطأة قيود تفرضها قوى غائبة ولكن تأثيرها حاضر قوي، غير أنه أي هذا الهروب يخفف من قبضتها.
ومع أنه في المجتمعات التي يكون فيها ما هو “اجتماعي” محافظاً على فضاء للنقض منفصلٍ جزئياً عن قوى النزعة الاستهلاكية والامتثال، فإنه من الممكن أن يظهر مثل هذا البعد أول ما يظهر في الفضاءات الجماعية (المشتركة)، في مجتمعات كتلك التي وصفها ماركوزه، ومن الضروري أن يحدث هذا الانفصال، أول ما يحدث، على المستوى الشخصي، كتأكيدٍ على رفضٍ، أو كمسافة لازمة تؤسس لانفكاك عن النظام، وبالتالي لانفكاك عن الأشكال الراسخة والمعمول بها التي تتشكل بها الجماعة في ظل هذا النظام.
وإنما يصبح إعادة تكوين علاقات اجتماعية على أسس مختلفة ممكناً، بعد انفكاك كهذا، علاقات تتشكل بين أولئك الذين حدث فيهم هذا الانفكاك.
الهوامش:
[*]: أندرو روبيسون: منظّر وناشط سياسي، يعيش في بريطانيا، كتابه (Power, Resistance and Conflict in the Contemporary World: Social Movement Networks and Hierarchies)، (ألفه بالاشتراك مع Athina Karatzogianni)، نُشر في سبتمبر 2009 لدار النشر Routedge، وله عمود (In Theory) يكتب فيه جمعتين في الشهر.
[1]: ترجم جورج طرابيشي كتاب ماركوزه (الإنسان ذو البعد الواحد)، وبين يدي طبعة دار الآداب- بيروت (1988)، الطبعة الثالثة. ولذا فترجمة عنوان الكتاب، بهذه الصيغة، تُنسب لطرابيشي. كما أني استفدت في هذه المقالة من ترجمة طرابيشي لبعض المصطلحات الإنجليزية التي وردت في كتاب ماركوزه. وفيما يلي تلك المصطلحات:
المكافئ العربي (ترجمة طرابيشي)
المصطلح الإنجليزي (تعبير ماركوزه)
الاتضاع:
Repressive
الضمير التعيس
unhappy consciousness
الضمير السعيد
happy consciousness
العقلانية التكنولوجية
technical rationality
[2]: “عالم المعنى” (Universe of Meaning) كما عرَفه بريجر ولوكمان، مستمد من المجتمع، إنه معنى ينتجه المجتمع، ومن جهة أخرى ينتج المجتمعَ. عالم المعنى ليس محصوراً في أفكار الفلاسفة المرموقين عن المعنى والحياة، ولكن يشمل ما في المعرفة اليومية مما نأخذه على أنه من المسلمات. يتطلب عالم المعنى “شرعنة” مستمرة، يحتاج إلى تعزيز وتبرير متكرر. يلزم إخبارُ أعضاء المجتمع بأن عالم المعنى الخاص بهم واقع وحقيقي وصحيح، و”مشرعَن”، وبدون هذا الدعم “قد ينسحب عالم المعنى نحو الانهيار، وقد تكون الحياة بلا معنى، وقد يكون استقرار المجتمع مهدداً”.
[3]: الاسم المستعار للمؤلف الأمريكي بيتر لامبورن ويلسون (كاتب سياسي، أناركي النزعة، ولد عام 1945).
[4]: نحت ماركوزه هذا المصطلح في مقالة عنوانها (Repressive Tolerance) في كتاب (Critique of Pure Tolerance: 1965)، الذي كتبه ماركوزه بالاشتراك مع Robert Wolff وBarrington Moore. ويشير هذا المصطلح إلى “القبول السلبي للممارسات والسياسات الاجتماعية والحكومية التي تقيد الحرية بمعناها المطلق”.
“يجادل ماركوزه بأن الاتضاع بالقبول يظهر في صورتين أساسيتين: (1) القبول بلا تفكير بالمواقف والأفكار الراسخة، حتى وإن كان ذات ضرر بيّن على الآخرين، أو، مثلاً، على البيئة (الاستجابة البطيئة، على نحو مُشعِر بالمرارة، للتغير المناخي والتدهور البيئي قد قد يُرى على أنه مثال على ذلك)؛ (2) التأييد الصريح لإجراءات تتسم بعدوانية واضحة تجاه أناس آخرين (الدعم الشعبي في الولايات المتحدة وبريطانيا في أعقاب 11/9 و7/7 لمحاولات الحكومة المعنية لإيقاف أو الحد من استصدار أوامر المثول أمام القضاء مثال واضح على ذلك)”. وضعتُ المقابل العربي لـ(repressive tolerance) مستفيدة من ترجمة طرابيشي لمصطلح (repressive desublimation)، انظر: هامش رقم (2)، ولعل الأول لم يرد في كتاب (الإنسان ذو البعد الواحد)، أو أنني لم أعثر عليه في الكتاب.