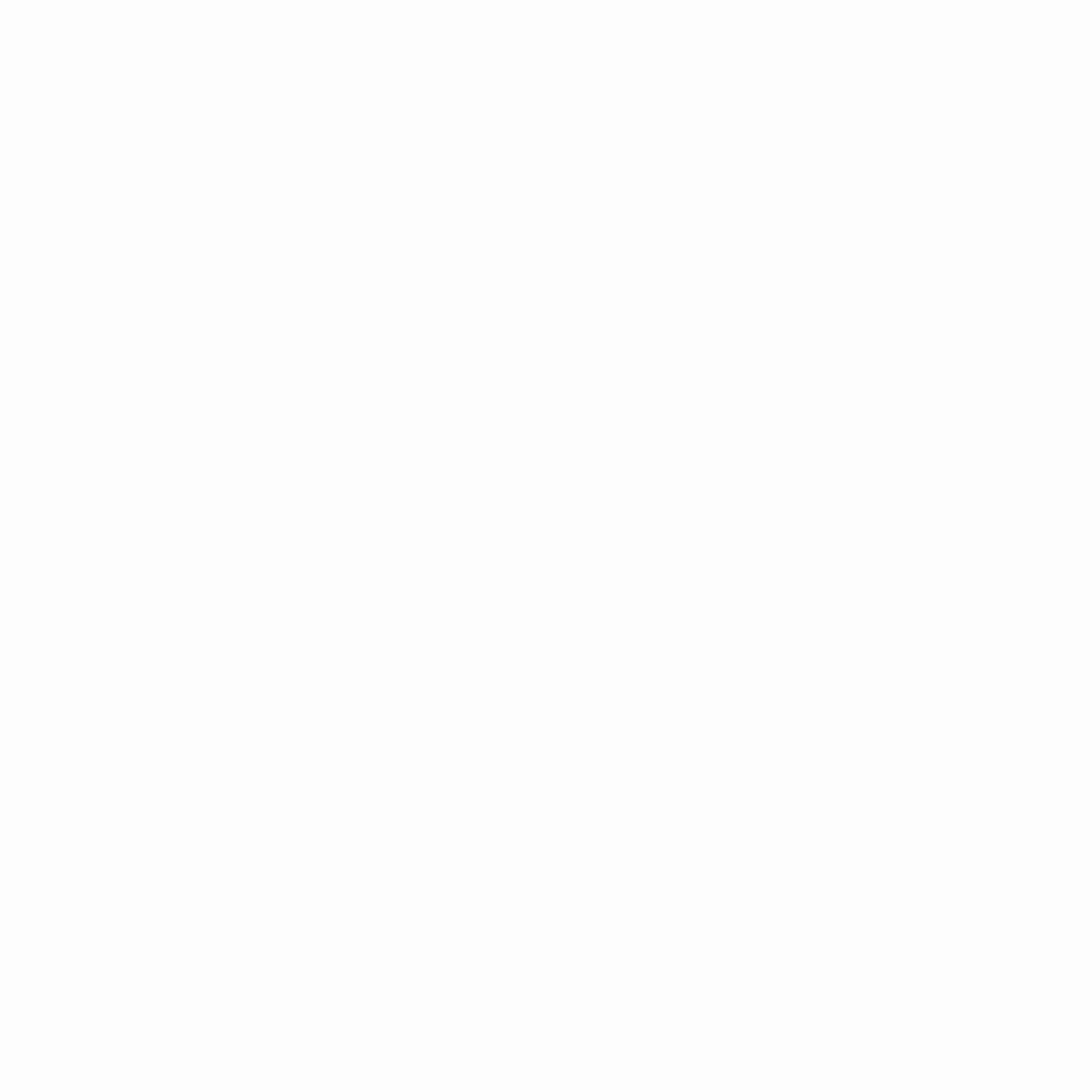“المُتَشَبِّعُ بما لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.”[1]
من تظاهر بما ليس فيه (من الصفات،) أو ليس له (من الأشياء) فهو كلابِس ثوبَيْ زور.
التظاهر -كما أفهمه- هو: تَزيُّنٌ يبدو على هيئة الإنسان، ويتلبَّس بمظهره. ومعنى التزيّن قد يُحمل على ما يتزين به الناس عند (أو على) أقرانهم[2] من الزينة المادية، الظاهرة (في الملبس، والمسكن، والمأكل)، وقد يُحمل على (الصفات والمعاني) التي يتزين بها، ويستجلب بها المدح أو المكانة في محيطه الاجتماعي.
يجعل الحديث من تظاهر بامتلاك ما لا يملك (من الأشياء، أو المعاني) كمن بلبس ثَوبَي زور. يأخذ الحديث ما هو “دنيوي”: من مظاهر الأشياء التي يتزين بها المرء عند أقرانه، فيعطيه -فيما فهمت- قيمة دينية أخلاقية.
لطالما كان المظهر، في التاريخ الإنساني كله، صورة معبرة عن القوة، ومادة للتدافع، لها قيمة تداولية (مادية ومعنوية) معتبرة في التعاملات الإنسانية، لم تغفلها الشرائع [3]، ولقد تساءلت: لماذا يأخذ الحديث تظاهر الناس بكثرة الأشياء، هذا المأخد؟، إذا كان المظهر “الخارجي”، والسلوك “الخارجي”، من أمر الناس يتعاملون به في دنياهم، وفق طبائعهم، وطبائع أزمانهم، فلماذا يأخذ قيمة دينية؟ . وهذا التظاهر ليس متعلق بعبادة يكون صاحبها مُرائياً، إذا ما أراد أن يرى الناس عبادته، بغية التباهي وطمعاً في السمعة “الحسنة”.
يبدو لي أن الأمر راجع إلى عدة أسباب، وقد يكون منها:
أن الاستكثار (المزيّف)، أياً كان مصدره: استعارة المرء مظهراً لا يملكه، أو ادعاء لفظي بامتلاك ما ليس يملك، أو الإيهام بالامتلاك بأي صورة، فيه تشويش للآخرين؛ إذ الإنسان من طبعه أن ينظر إلى ما عند غيره من الأشياء، والمجاراة سنة الأقران، والمرء يشعر بنوع من الإلزام بقيم محيطه، ومعايير محيطه، وما يراكمه محيطه من الأشياء والمعاني.
هذا، كله -إن تأملت- سيدفع مجموعة من الناس إلى دائرة التنافس، وينحّي التنافس، الذي كان أصلاً منصرفاً إلى (امتلاك أشياء) إلى دائرة أخرى، هي التنافس على (تزييف صور لامتلاك الأشياء)، هذا التزييف له وسائله وأدواته: فلِكَي تظهر بصورة من يملك الأشياء: قد تتحصل عليها بعدة صور، وهذا قد ينتج سوقاً؛ سوق تُعيرك، وتُقرضك، وتُزييف لك، تبيعك هذا كله.
ولا ريب أن هذا “السعي” شاغل للمرء (في فكره، وشعوره، وماله)، غير أن هذا الانشغال متنامٍ بطبيعته، يتغذى على التكرار حتى ينصب معايير جديدة: ينمّي السوقُ التظاهرَ: بأن يُنتج، ويسوّق صور الأشياء. وإذا ما يسّره السوق، وقدّم له (تسهيلات) سيروّجه الأقران بتكرارهم لهذا المظهر، حتى تُؤَسس أنماطاً سلوكية جديدة، يعتبرها الفرد -فيما بعد- معياراً إذا اطّرت في أقرانه، وقد يشقّ تجاوزها أو النأي عنها.
وإذا كان امتلاك الأشياء محدود بالقدرة المالية، فإن الاستكثار من المظاهر حدوده أوسع، لأنه غير مقيّد بالإمكانات المادية، لا يتوقف عند ما تملك (أو ما تستطيع أن تملك)، بل سيتجاوزه إلى القدرة على التظاهر، مما قد يبني نمطاً سلوكياً عند الأفراد، يؤثر على المجتمع. وبذلك، تعمّ البلوى بالتظاهر، وقد يصبح من طبائع الأشياء.
ثم أن هذا الأمر قد يضرّ بمعايير الفرد من جهة أخرى، إذ تتوجه عنده قيم الأشياء والمعاني إلى ما يظهر منها، تقاس عنده القيمة بظاهر الأثر، فتكون قيمة العمل منصرفة إلى (ما يظهر) من العمل، وتنحصر قيمة الإنجاز في (ما يُرى) أو يُقدّر من الإنجاز، ويصير الجميل والحسن هو (ما يلاقي) الاستحسان.
يشوّش هذا معاييرك الفكرية، لأنه سيجعلك – في إعلائك لقيمة المظاهر- تتأول أوجهاً تسوّغ بها سلوكك. ويضرّ بمواقفك الأخلاقية حين تجعل لمظاهر الأشياء قيمة مركزية مقدمة، تستهلك من الوقت والجهد والمال ما حقه أن ينصرف إلى غيرها
وقد كان الإنسان، تاريخياً، يتزيّن على أقرانه -فيما يتزيّن- بمعان عالية مقدَّرة: بالكرم، والزهد، ثم صارت الزينة -في زماننا هذا- منصرفة إلى أشياء محضة، مصمَّمة لِتُنزع منها أي قيمة حقيقية؛ مادية أو معنوية، وكلنا – لو تأملت- عالقون بقَدْرٍ من هذا.
“ربِّ يسِّر وأعِن”
هوامش:
[1] صحيح مسلم (2129)
[2] معلوم أن التزين قد يتفاوت من زمن إلى زمن إلى زمن، لأن معناه منصرف إلى ما له قَدْرٌ عند الناس (من المعاني والأشياء)، وقد ورد في شرح الحديث: ” كمَنْ يَلْبَسُ لِباسَ ذَوِي التقشُّفِ ويَتزيَّا بزِيِّ أهلِ الزُّهد والصلاحِ والعِلم وليس هو بتِلك الصِّفةِ” (موسوعة الدرر السنية: شرح الحديث)
[3] فنفقة المرأة مثلاً تقاس بـ(مستوى إنفاق) مثيلاتها من النساء، وضابط الزهد هو: زهد الإنسان بامتلاك مثل ما عند أقرانه.