تقول عائشة للنبي:
“يا رسولَ اللهِ، كلُّ صواحبي لهن كُنى”.
يقول لها النبي:
“فاكتني بابنك عبدالله”.[1]
فما قال النبي لها: أنت أم المؤمنين، كُلهم أجمعين.
ولا وقال : أنت عند نبي الله، وإنك لأحب الناس إليه.
ولم يقل: عُدّي نِعَمتك، ولا قال: لا تمّدِنّ عينيك إلى ما عند صواحبك.
ولم يعظها في فناء الدنيا، ولم يحدّثها -في هذا الموقف- بثواب الله للمحسنات من نساء النبي.
لم يلفَتَها إلى الموجود عندها من العطايا، ولا وجّهها إلى فهمٍ يستحيل به المَنع عين العطاء، ولا نبهها إلى ما اختُصت به من المواهب: وهي إمامةٌ في البيان، ومعلمةٌ للمؤمنين الدين، وما بشّرها بحالٍ من خدمة الدين يُقيمها الله فيه.
أرادت كُنية، فأعطاها ابناً.[2]
يا للنبي!
هل النبي أبٌ للمؤمنين إذا زوجاته أمهاتهم؟ اللهم صلّ وسلّم على رسول الله.
[1]
في مناهج دراسة النفس مقاربةٌ لسويّة الإنسان، تقول إن للإنسان -مهما كان- ضرورات من الحاجات النفسية[3] (مثل: الحاجة إلى المعنى، الأمان، الإنجاز، الصحبة، وغيرها)، وإن تلبية بعض هذه الحاجات -مهما لُبّيَت- لا يسد عن غياب بعض، وأن تلبية هذه الحاجات النفسية على وجه التمام قد لا يتحقق لكل أحد، وقد يغيب بعضها أو يشح، مع وجود بعضٍ، فإذا غاب بعض منها فبابُ طلَبه إنما يتأتى من جهة صلة المرء بغيره.
ثم إن كل واحدة من تلك الحاجات إنما تُسدّ من جنس نفسها لا من جنس سواها، يتلمسها المرء من محيطه، يُقاربها ليظفر ببعضها، أو يستثمر إمكانياته أو متاحاته ليهيأ لنفسه شيئاً منها. وهو في سلوكه الطريق قد تتحقق له حاجات من جنس ما أراد، وقد تُفتح له في الطريق أبوابٌ، تسدّ بها له حاجات أُخر.
فكأن اضطرار الإنسان إلى حاجاته طبعاً مركّب فيه لتتم صلاته بما في البيئة والمحيط من الأشياء والروابط. يقارب المرءُ البيئةَ والمحيط مقاربة حسنة واعية، لتتأتى له بها سدّ حاجاته النفسية، فيكون ترابط المجتمع ناشئ من حاجات الفرد في رحلته لِتَطَلُّبِها (عائشة مُنِحت كنيتها من جهة ابن أختها أسماء).
ونحن حين نقول: (ما يريده المرء لنفسه) نقصد: مرادات الإنسان في الحياة مطلقا، ومرادات الناس تتقاوت، ولكنهم مجتمعون في وجود ضرورات نفسية لهم، يطلبون بهذه المرادات سد شيء من الحاجات النفسية الضرورية: فهذا يريد رزقاً، وذاك يطلب ترقية، وذاك يريد شيئاً، يتوجهون بهذه المرادات إلى سدّ شيء من ضروراتهم النفسية؛ مثل الشعور بالمعنى، والشعور بالمكانة، والشعور بالانتماء، والأمان، وغيرها، كُلّ يطرق لها باباً أو تتأتى له من جهة.
[2]
وقد يطول الطريق أو يقصر، وقد تكون الفُتوح في الطريق من جنس المرادات، أو من غير جنس المرادات (أي أن المرء يوهب شيئاً وهو يرى ضرورته في غيره)، وقد يهبه الطريق من الدروس والمعاني ما تكون له بها تجربة إيمانية يتعاظم أثرها في نفسه وفهمه وتوجهاته في الحياة.
ولا غرو في أن انصرافك إلى خير آخر تؤتاه -في مقابل مُراد مُنع عنك فتوجهت إلى غيره- فيه خير عظيم، فيسرّك في نَفسك ومن نفسك انصرافك إلى باب خير فُتح لك، وتتحرى أثر هذا الخير في قابِل أيامك، فتسلو به نفسك. غير أنك غير محتاج إلى أن تتخذ من كَسباً تكسبه، أو نجاحاً تحققه، أو عملاً تعمله، أو فنّاً تتقنه، أو أثراً تتركه هويّة تَعرف بها نفسك، فكأنك تفحص بها ما أُعطيتَه إلى ما مُنعتَه، أو تَزِن بها ما عندك إلى ما عِند أقرانك. ستوهب مواهب في مقابل المنع، لكن لا تتخذ من مواهبك هذه هويّة، ثم أَرخ كفّك عن القبض على الأشياء، لكن حثّ خَطوك في المسير. تأمل أقدار الله تحفّك وتتفتق لك منها معانٍ وأرزاق على طول الطريق.
وارض بما أوتيت، واقبل عطبك، فالمرء إذا لم يَقبل بعطَبه (الحسي أو المعنوي) يتولد له من آثار هذا العَطب أعطاب أُخَر.[4]
هوامش:
[1] الحديث في صحيح أبي داود (4970)
[2] وعبدالله هو ابن أسماء أختها، ابن الزبير. ما قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: “فاكتني بعبد الله، ابن أختك، فالخالة أم”، مثلاً. وإنما قال: “بابنك”، فنسب بنوته إليها، في عبارة نبوية تُزَيِّل المجاز في الكنية!
[3] تصنيفات الضرورات النفسية (أو الحاجات الشعورية -كما تُسمى) تتفاوت عدداً ونوعاً كما هو معلوم، ومنهم من يجعلها مراتب. انظر: هنا.
[4] وإلى هذه الفكرة نفسها تعود الأعطاب/ التشوهات التي قد تنتج عن عمليات التجميل، وكثيراً ما تَنتُج.
لا أظن النص محتاجاً تنويهاً إلى أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يُحمل على مناهج النظر في النفس، وإنما هو نظرٌ في جواب النبي، كيف أجابها بشيء من جنس ما تطلعت له نفسها، لم يصرفها إلى حالٍ تتجرد بها عما أرادت.
في المسافة بين القصد والقول:
ضنّتْ صواحبي بهذا النص على المدونة عاماً أو يزيد عن عام، غِرْنَ على المقال من الأفهام؛ أنّ كل فَهمٍ سيَحْمِل النص على قَدْر وِسعه.
لولا أن شيخي قال لي يوماَ -معاتباً ومؤنباً-:
“أنا مضطرٌ أن أقول لك أن عندك تأملاتٍ … [وَصَفها]”.


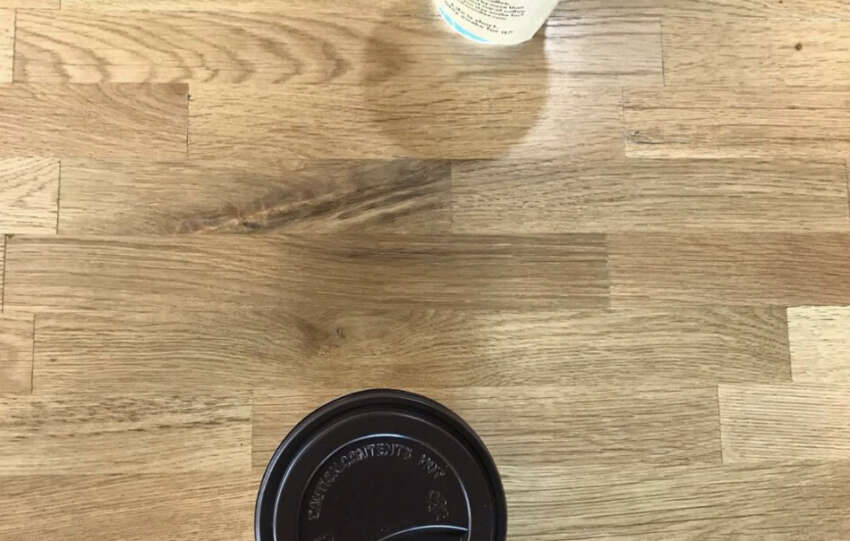

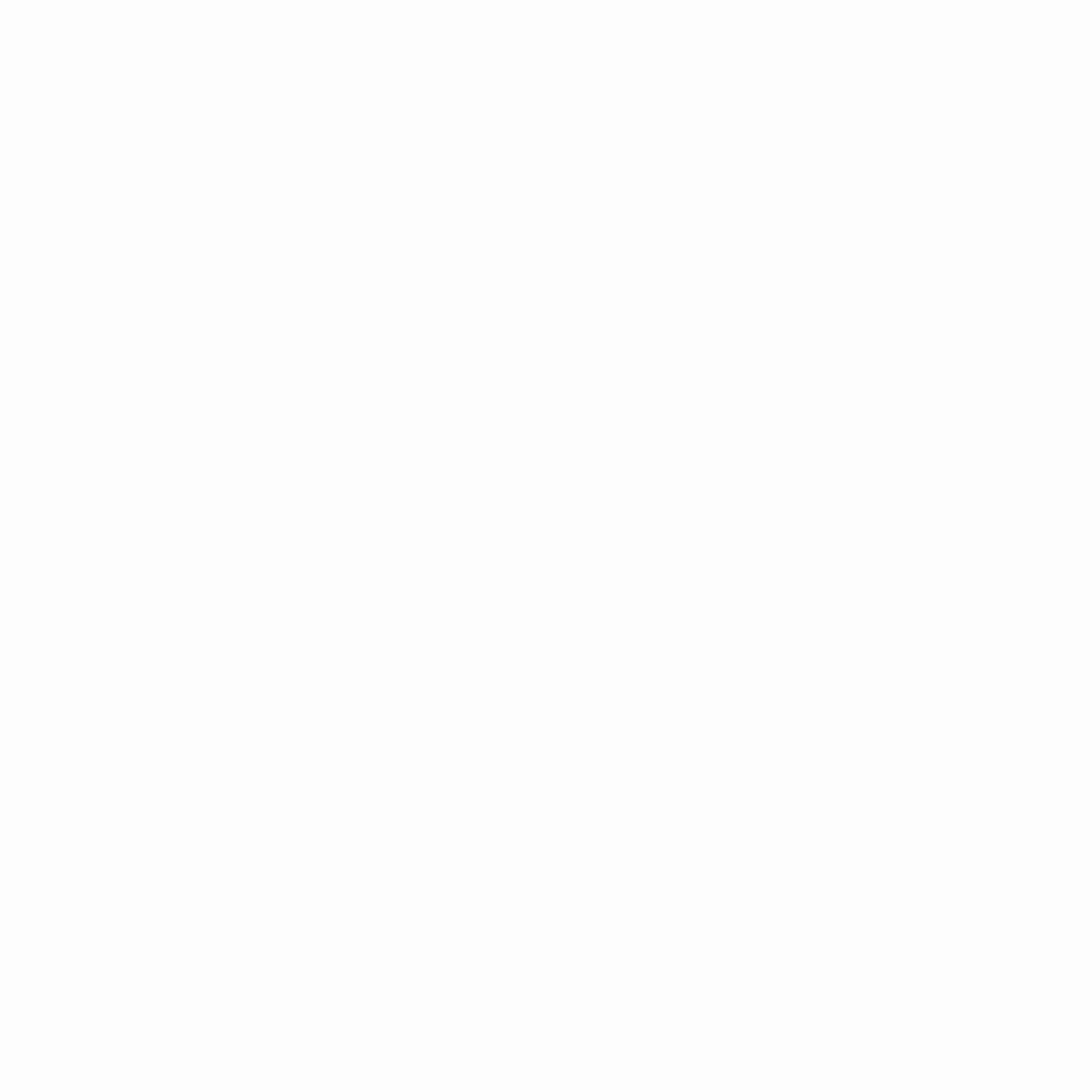
5 من التعليقات
اسماء
ابحرت في بحور فكرك الراقي جدا..
اللهم صل على رسول الله
تسنيم
الحاجات تشبع من نفس جنسها..
أحسنت القول
حصة
أَعيُنكن، أَعيُن الصواحب صانت النص، وعَوَّذته، وباركَته.
مريم
أنتِ معالجة بالمعنى من الطراز الأوّل؛ فلسفة وعلم نفس وحساسية ومواجدة ممزوجين بثقافتنا وهويتنا،،،
زادك الله علما ،،
حصة
🩷🩷