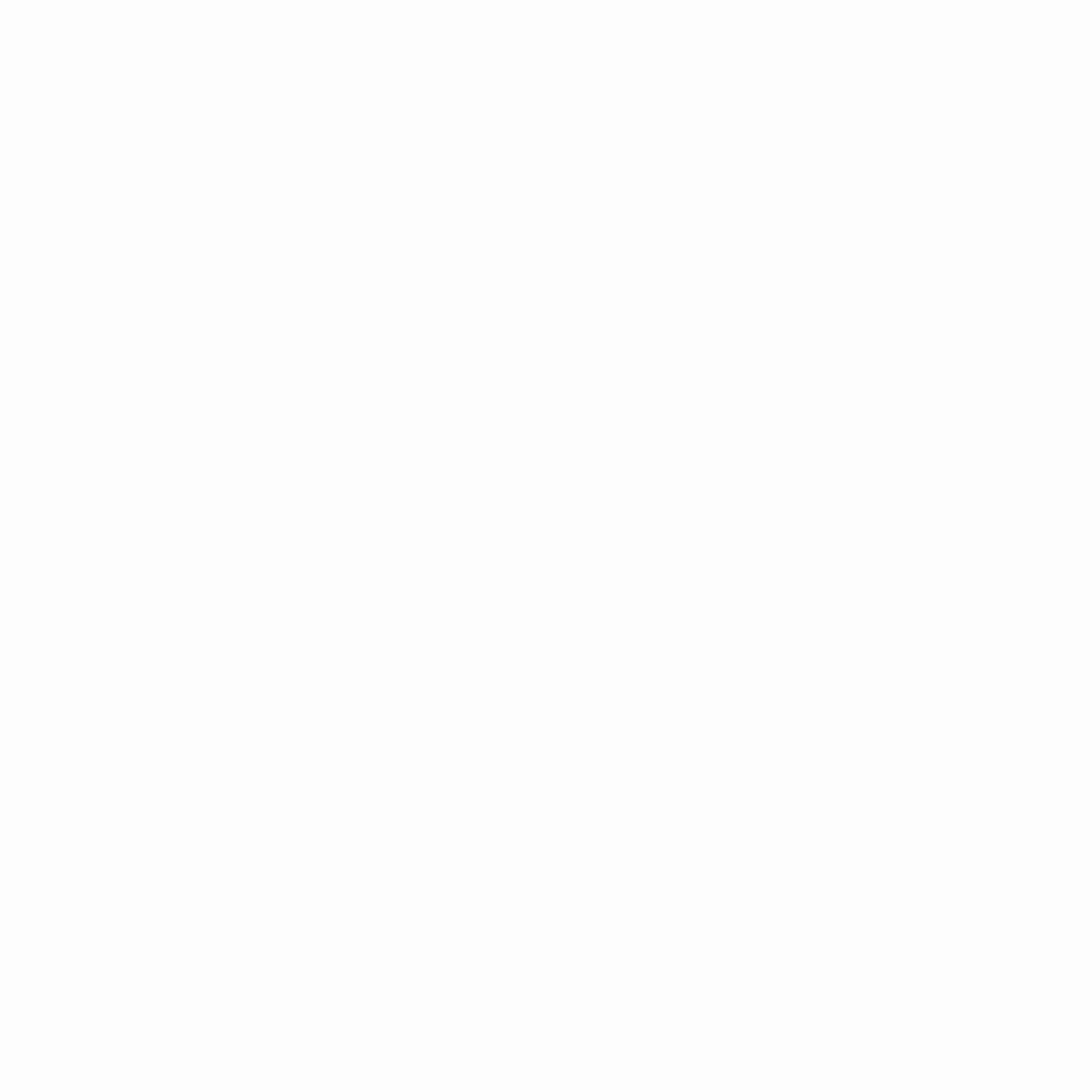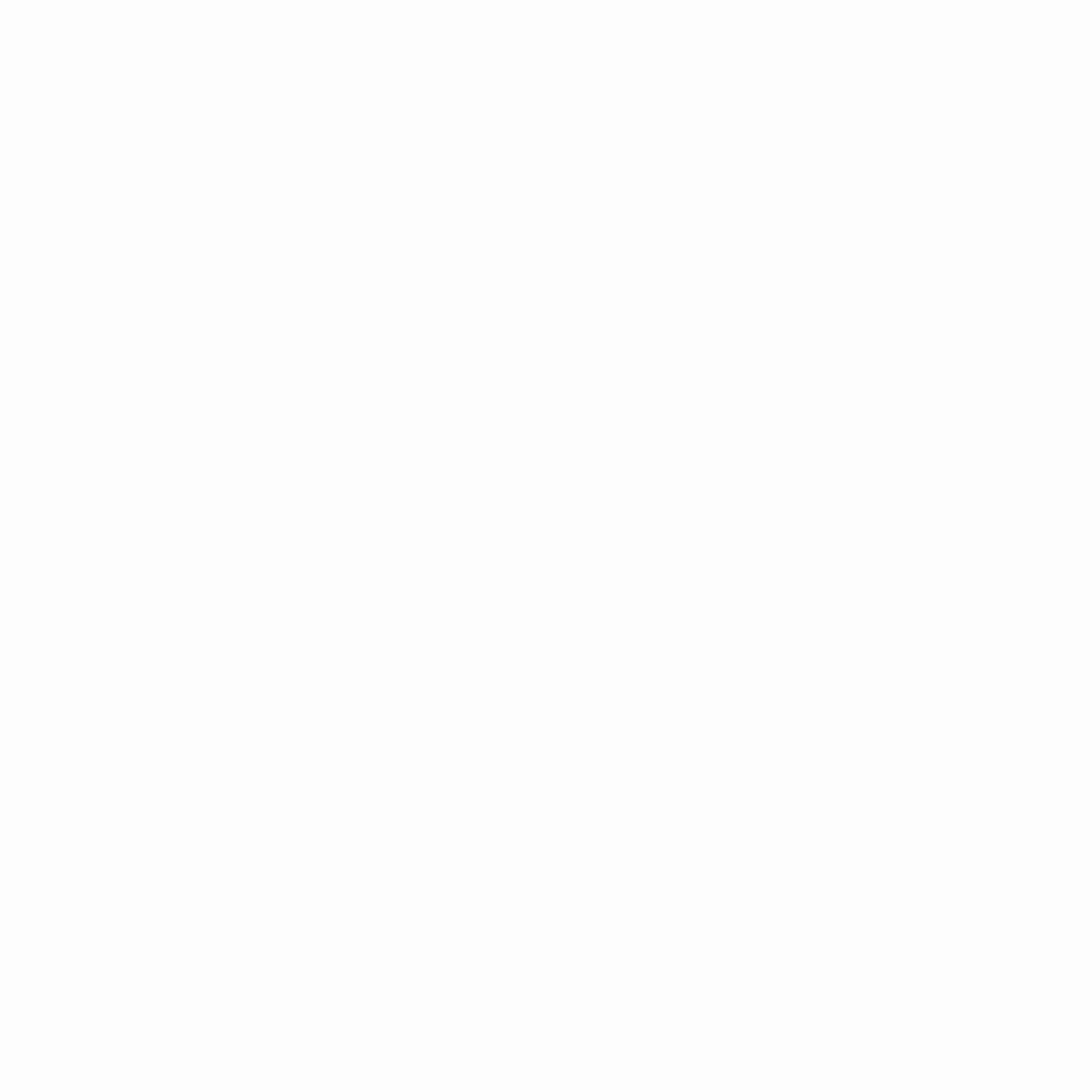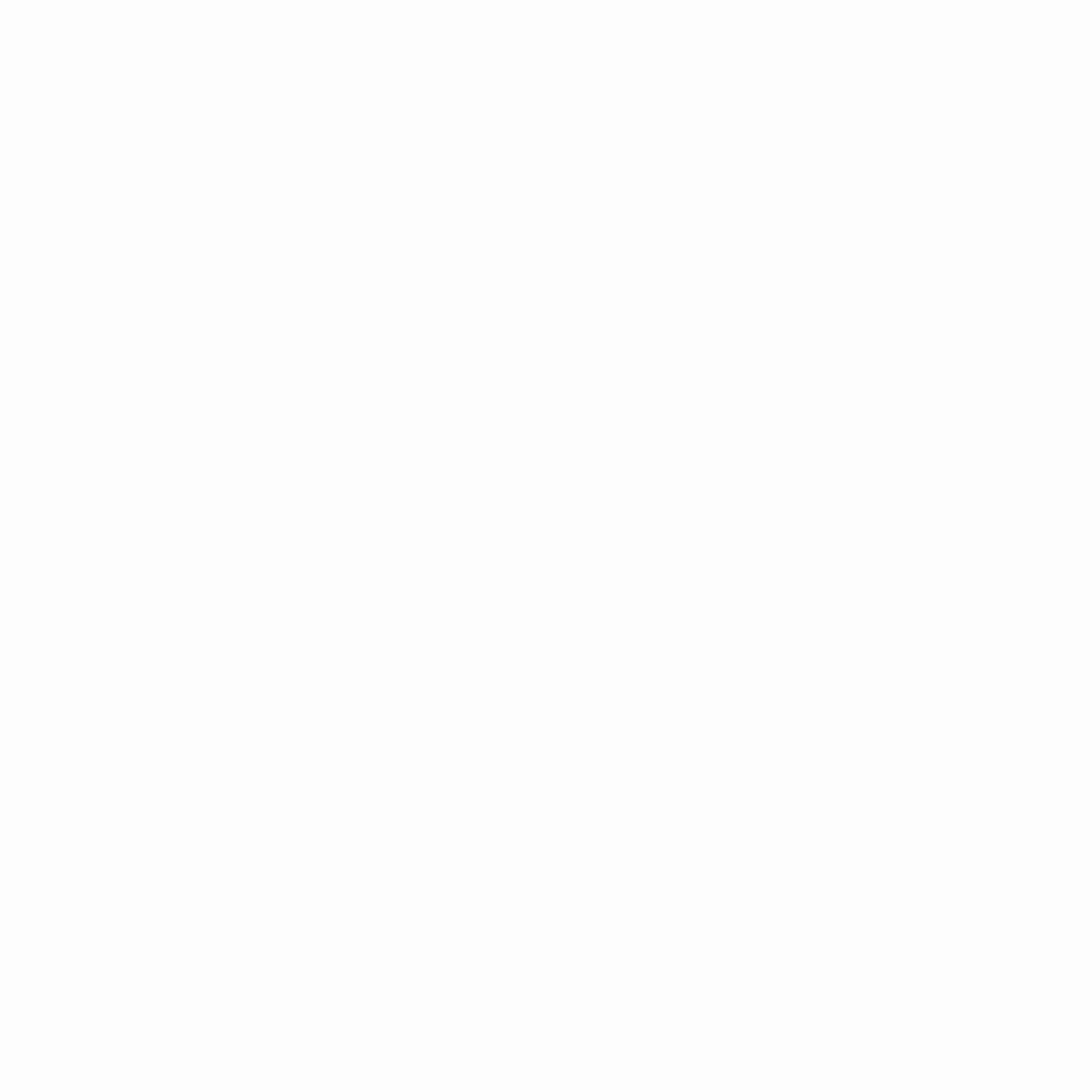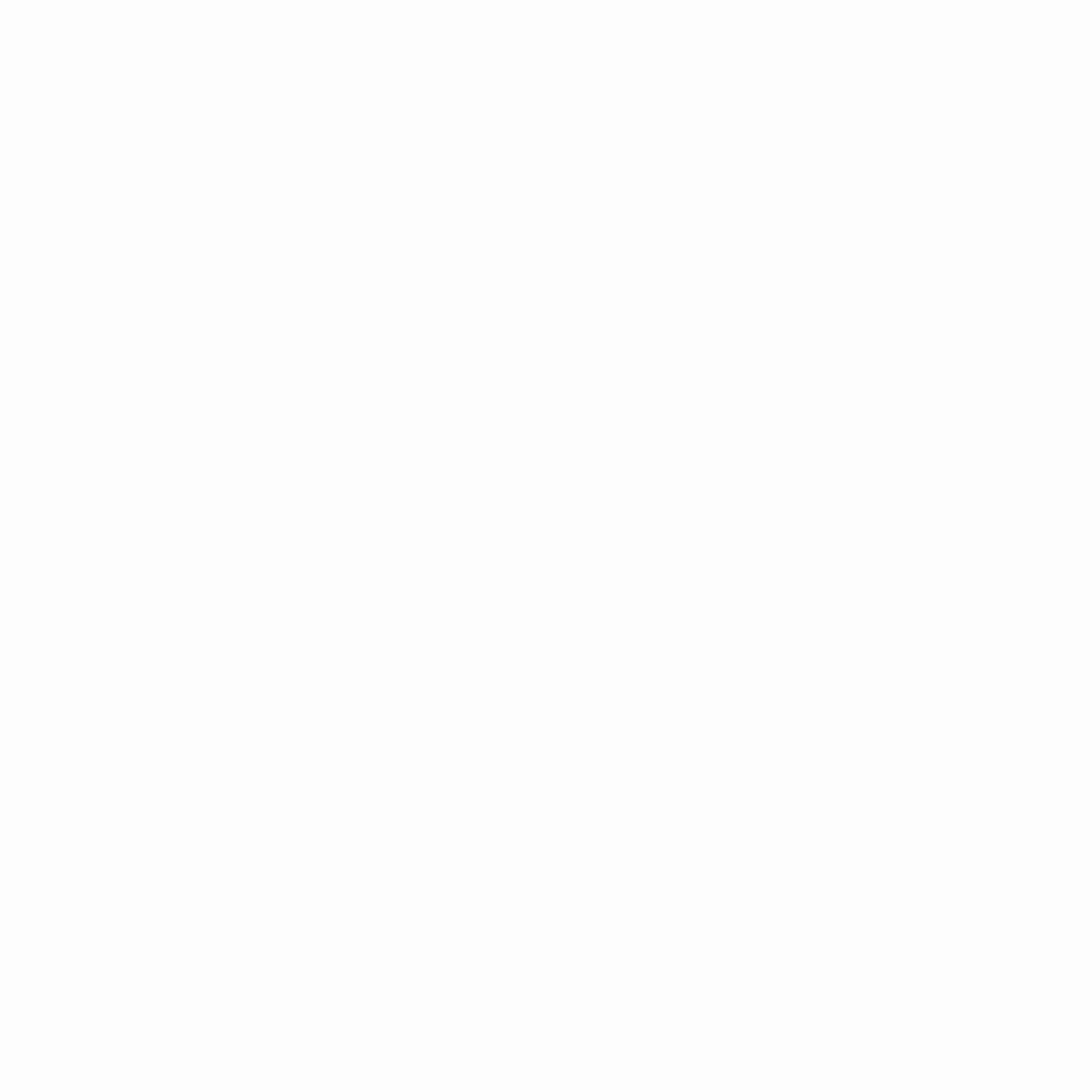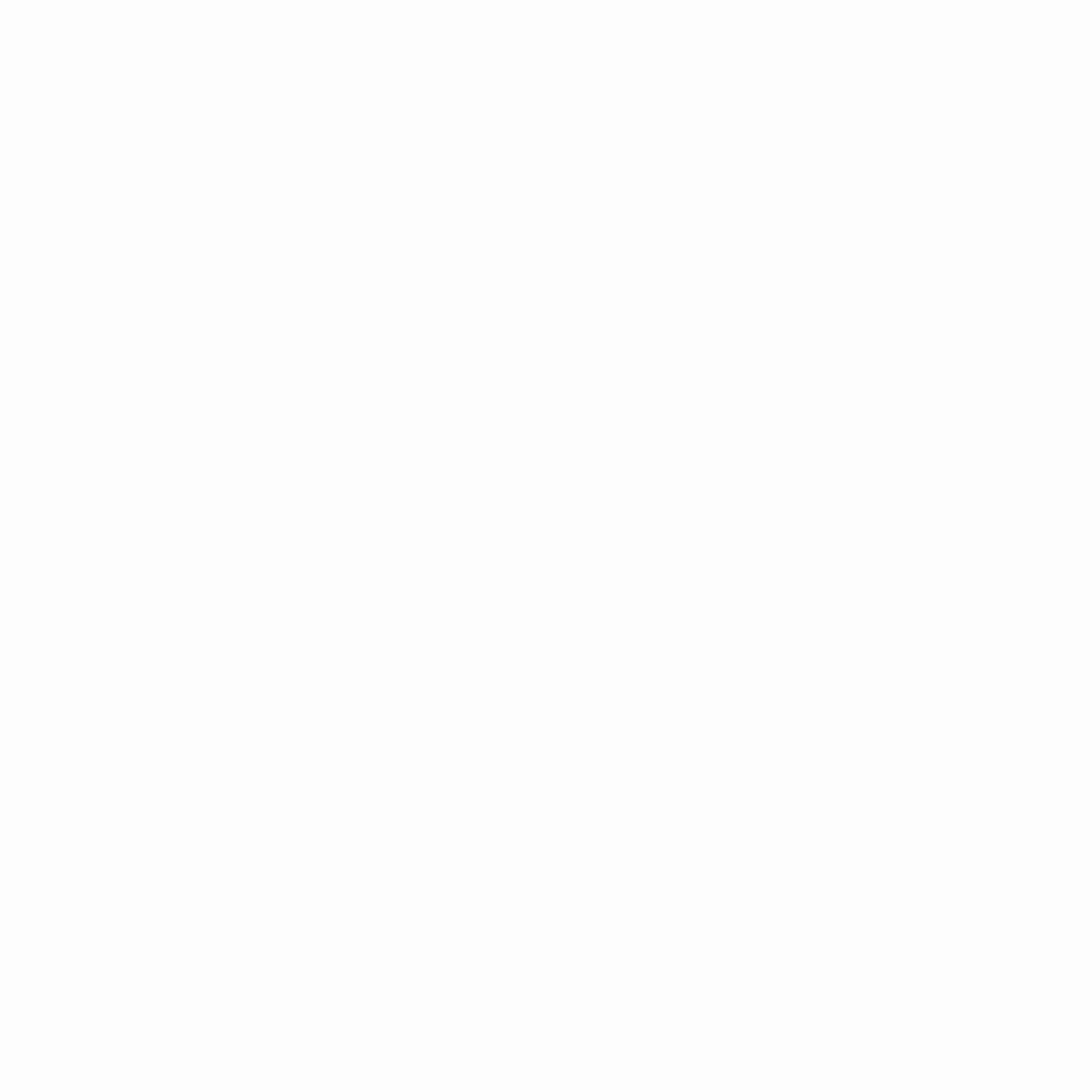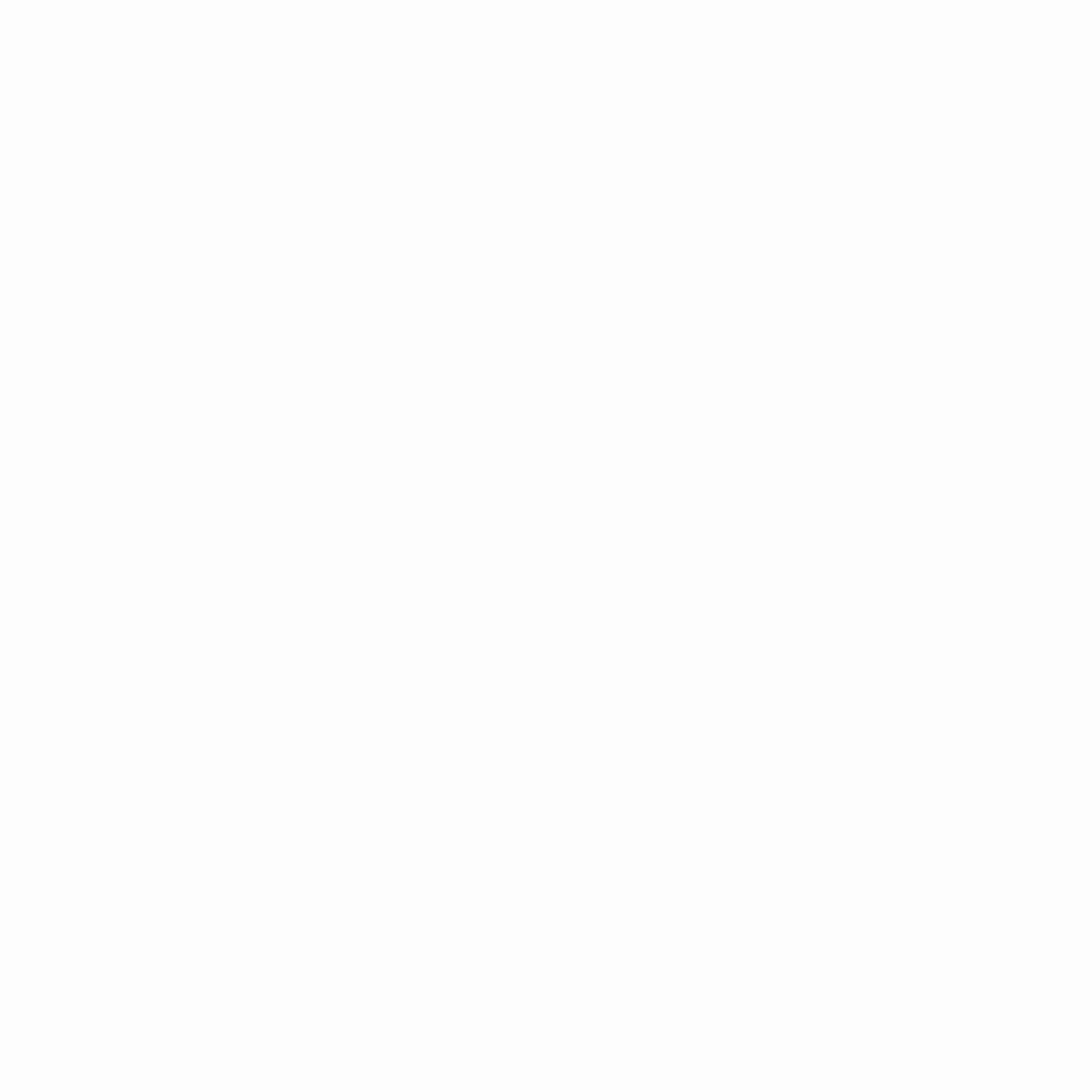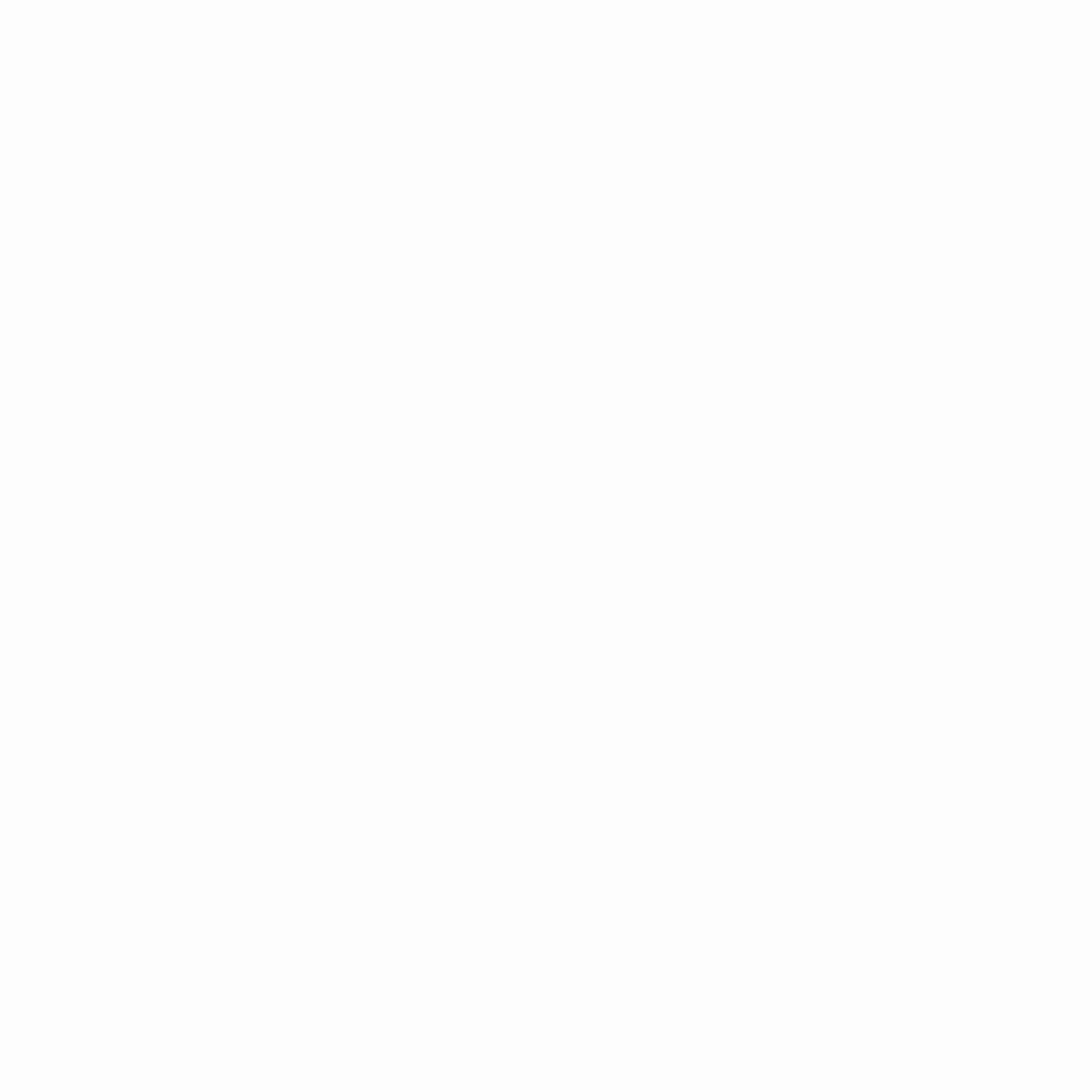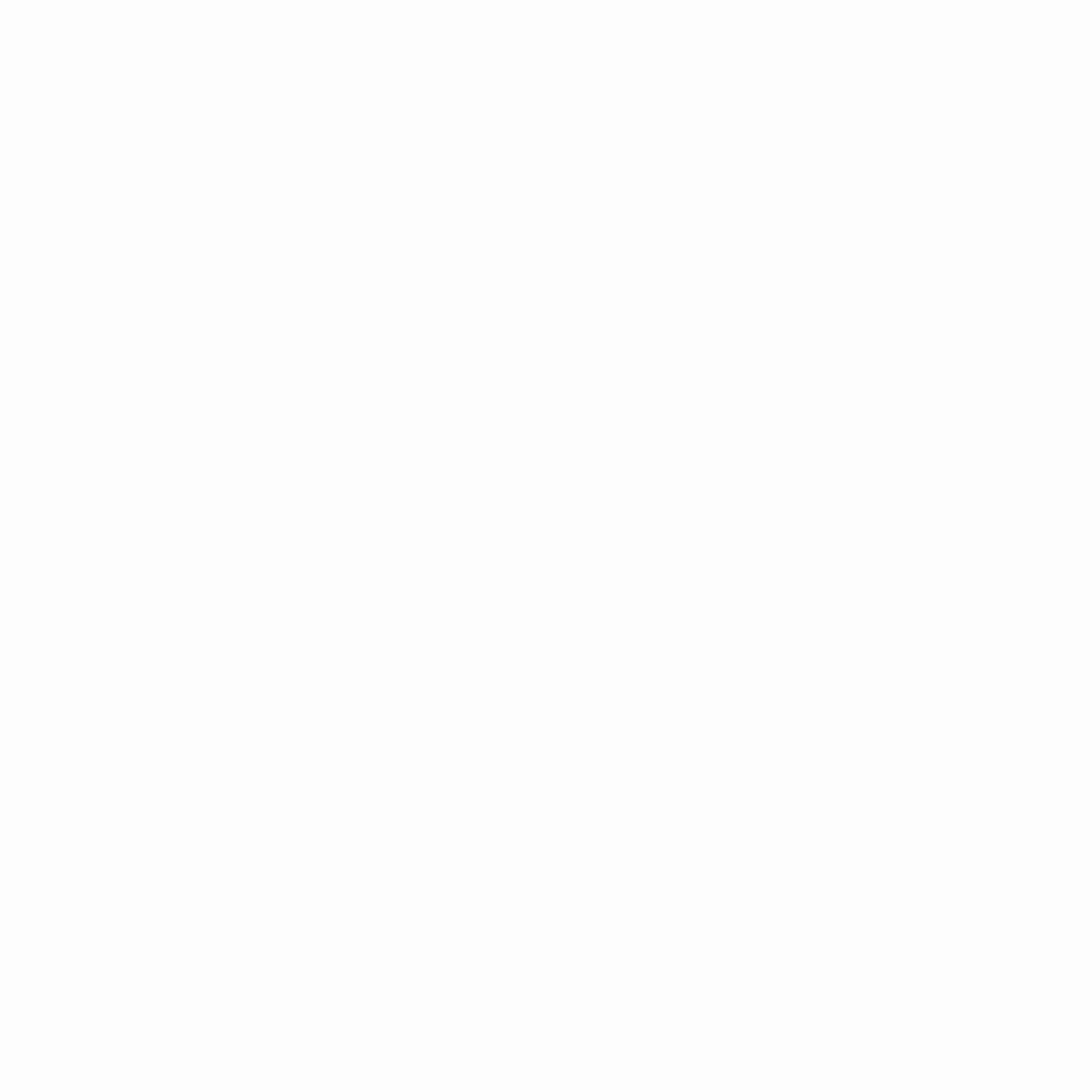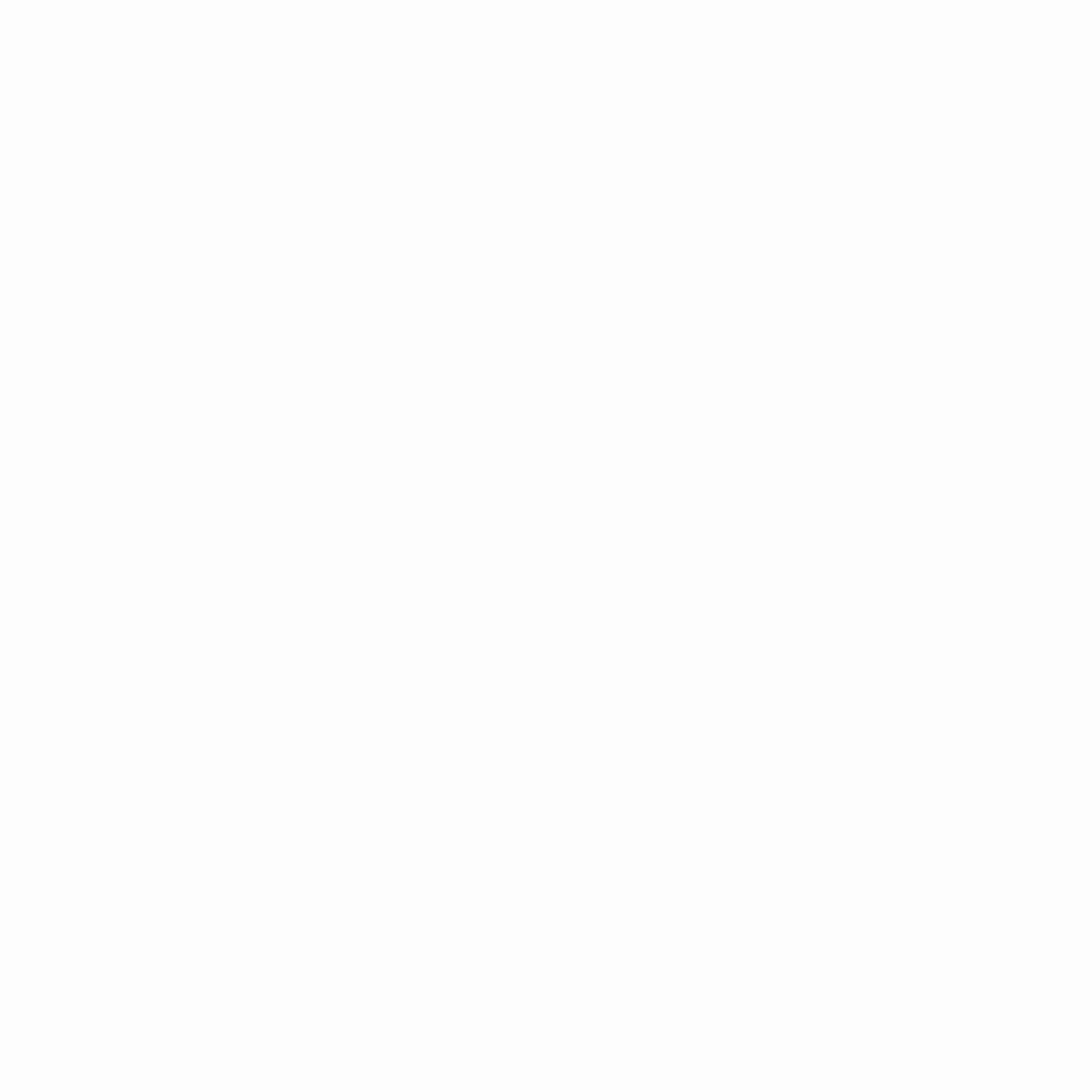كادت هذه التدوينة أن تكون: في مديح مؤسسات العمل الخيري الكويتي.
أنت تعرف عملهم وتخبره -منذ حصالة (من يمسح دمعة هذا المسكين؟)، ومنذ بطاقات الجدول المدرسي المطبوع على ظهرها صورة لطفلة أفريقية ترتدي ملابس مدارسنا الحكومية-، ولكنهم مازالوا يبهرونك في كل مرة، حاضرين في الميدان كأنهم مزروعون فيه، أو يفزعون إليه كأن لهم زرقاً خالصاً في زواياه، حتى لقد ظننتُ أنْ لو كان الإخلاص -بمعناه المهني لا الديني، فلسنا نزكي على الله- رجلاً، لوجدتَ له مكتباً في مؤسسات العمل الخيري الكويتي.
ثم إن سألتهم عن هذا قالوا: إنما هو إرثٌ قد ورثناه، عن فلان عن فلان عن فلان. يعدّون إخوانهم الذين سبقوهم، كأنما لهم في درب الخير سنداً متصلا.
استشهدت محاسن ودُفنت -شهيدة بإذن الله- في مشهد لم يكن فيه سوى رجال لا يبلغ عددهم أصابع اليد، ولا بأس عليها، فقد استغنت بجوار الكريم. وأبقت أماً ما زالت محاصرة في جباليا مع شقيقين كفيفين.
ومن أجل أن يواسي الميت الحي، ويطعم الناس بعضهم بعضاً إكراماً لأحيائهم وتكريماً لموتاهم، أُقيم لها -برّا وصلةً- تكيّة إطعام (مطبخ خيري أوّلي) في مقر جمعية خيرية بجوار مخيمات للنازحين في دير البلح: قدور منصوبة على فحم، ورز ومرق بازلاء.
تولت أختها معاونة الطهاة، ثم -بعد أن نضج الطعام- تولت سَكبه في أوعية النازحات. وكان الطعام قد شحّ من السوق، وكان الناس قد تسامعوا، من اليوم السابق أن تكية تقام هنا فتوافدوا. وكانت الجمعية قد تكفلت بالتنفيذ شهراً، لأن الطعام لم يعد قادراً على شرائه أحد، ومن الناس من يأكل ما وُجدت التكايا، فإن عزّت لم يجد ما يأكله -فرّج الله عنهم، أعانهم، أغاثهم، كفلهم، آواهم، أطعمهم، وآمنهم-.
تكفل المؤسسة الكويتية التكية، ويتولى التنفيذ مؤسسة محلية مرخصة من الجهات الرسمية في الكويت. تقيم المؤسسة في صفحتها رابطاً لجمع التبرعات للمشروع المعيّن (تحيل فيه إلى رقم الترخيص وتاريخ صلاحيته، الذي يمتد عاماً غالباً). تيسر الجمعيات للأفراد والمجموعات من الأصدقاء أو العائلات أو الزملاء التعاون معها فيما يرتؤون المساهمة من مشاريعها، كأنما تتخذهم شريكاً مقدّراً، ولا تزدري منهم دعما.
فإن أردت أن تسهم في مشاريع الإغاثة العجلى، فإنك تختار المشروع، ومقدار المساهمة، فتنشئ لك الجمعية رابطاً تستهم فيه (وتعيّن مساهمتك باسمك أو اسم عائلتك أو مجموعتك، لتخاطَب بها). يرسلون لك الرابط من ساعة طلبك أو من الغداة لا يتأخرون، كما لو أن لهم رزقاً مكتوباً من سهمك فهُم يُعجلونك إليه.
يذكرونك بشَطر زياد أو ببيته:
تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله
وإذا أردت تنفيذ مشروع الإغاثة، نفسه، لكن في بقعة لم تصلها مشاريعهم، بعثوا شركاءهم من الغداة إلى البقعة التي أردت، يفحصون درجة الاحتياج، وإمكانية التنفيذ، ويعودون لك بتقرير موثق عما يجب وما يمكن، ثم يباشرون التنفيذ أول ما يردهم إيرادك، إنْ في هذه البقعة أو في غيرها مما اقترحوه عليك. ثم عشية التنفيذ يعودون لك بتوثيق مصوّر للتنفيذ.
وصل التقرير؛ أن هذا المخيم لا تصله أي موارد من الطعام، وأن إحدى الجمعيات تتكفل بجلب الماء إلى النازحين فيه، وأن المنطقة المحيطة به كذلك، تواجه الشح نفسه، وأن بالإمكان تغذيته بوجبات لستمئة عائلة. نفذّت الجمعية الإطعام بعد أيام قليلة، وأنت لا تسألهم ما سيُطعِمون: “أرسل حكيماً ولا توصه”.
تتعاقد الجمعية مع من يتولى إعداد وجبات الطعام، في أماكن مهيئة لذلك، من طهاة مختصين. تصلك الصور، فإذا القدور ملأى باللحم. ولا يمكنك أن تميز الطهاة عن موظفي الجمعية، يقفون على القدور، يقلبون الطعام، يناولون الطهاة، ثم يغلّفونه على الطاولات، بأقدار متساوية، في أكياس، يصفّونها في سيارة الشحن، إلى المخيم.
يصطفّ شباب المخيم وكهوله طابوراً، لا ليأخذوا نصيبهم من الطعام، ولكن ليناولونها يداً إلى يد، حتى تصل إلى أبعد خيمة في المخيم، ثم الأقرب فالأقرب. يضاحك موظف الجمعية الأطفال وهو يمد إليهم وجبات عائلاتهم: “بدّك رز؟ والا لحمة؟ والا رز ولحمة؟”، يلوّح لطفل ثانٍ، تسمع صوت المصور خلف الكاميرا، يضاحك الأطفال أيضاً كأن له في ضحكاتهم قوتاً من المسرة.
هو مصور محترف تصوير المواليد كان له محل في غزة ، لكنه اليوم نازح يقيم في دكان استأجره ليقيم فيه، لكنه لم يقبل أن يتقاضى أجراً على التصوير الإغاثي، لولا اشتراط كان. ثم عزمنا عليه أن يأخذ نصيبه من وجبات الإطعام لعائلته الصغيرة ووالديه وأهله، لكنه أبى، إلا من صحن يعود به إلى عائلته الصغيرة.
كانت أنوار قد قالت إن طعام الستمئة عائلة أطعم ألفاً، وأن العابر وصاحب الكارّة قد أخذوا نصيبهم: “كلما أخرجنا صحنين كأن الله يضع مكانهما أربعة!”.
وأنوار نفسها -التي امتلأت خيمتها بوجبات الطعام قُبيل توزيعها كانت قد رفضت الاستبدال بخيمتها: “لا، شو خيمة؟ خليني أنام بالبرد، بس خلي الناس ياكلوا رحمة ونور”. وحين اقتسام الطعام نالت ما يناله غيرها من غير استكثار ولا ادخار.
ويدلك أحد على صاحب موهبة أو محترف، لتستعين ببعض خدماته المهنية، فيتأبى:
“أنا شايف أنو الشغل بسيط مش مستاهل، ولعيون صاحبي فلان بدي أعمله مني خدمة”.
كأنهم يرونك منهم ما تعرفه: مقدار جبّهم للعمل، حتى يكاد يكون هوية يعرف بها المرء نفسه، ويزداد استمساكاً به في الأزمات. تقول إحداهن، وقد عملت خمسة أشهر في الميدان في الحرب، مسجّلة بيانات لإحدى الجمعيات الكويتية، ثم فقدت العمل بفعل النزوح المتكرر:
“في قصف وفي خطر بكل مكان، لكن، انتي لما تطلعي من أجواء الخيمة وتطلعي تشتغلي، وتشوفي ناس، وتتعاوني مع فريق، وتقضي وقتك كُلّو بالشغل، تعملي شغلات تفيد الناس، تخرجي من شعورك أنو أنتِ مقيدة بخيمة وعايشة وسط الحرب”.
وأنت تعرف أنهم يتداوون بعمل اليد، بالساعد، وبالحركة الدائبة، وتعرف كم يعزّ على الواحد منهم -على شدة البلاء- فقْد أسباب الكسب، من يده لا من يد غيره.
وتخرج أنت من هذا لتحكيه، ديناً على اللغة، واستصحاباً لأرزاق لا ترى، ولُطف يتنزل، تكاد تتلمسه الأيدي ولكن لا تراه العيون.