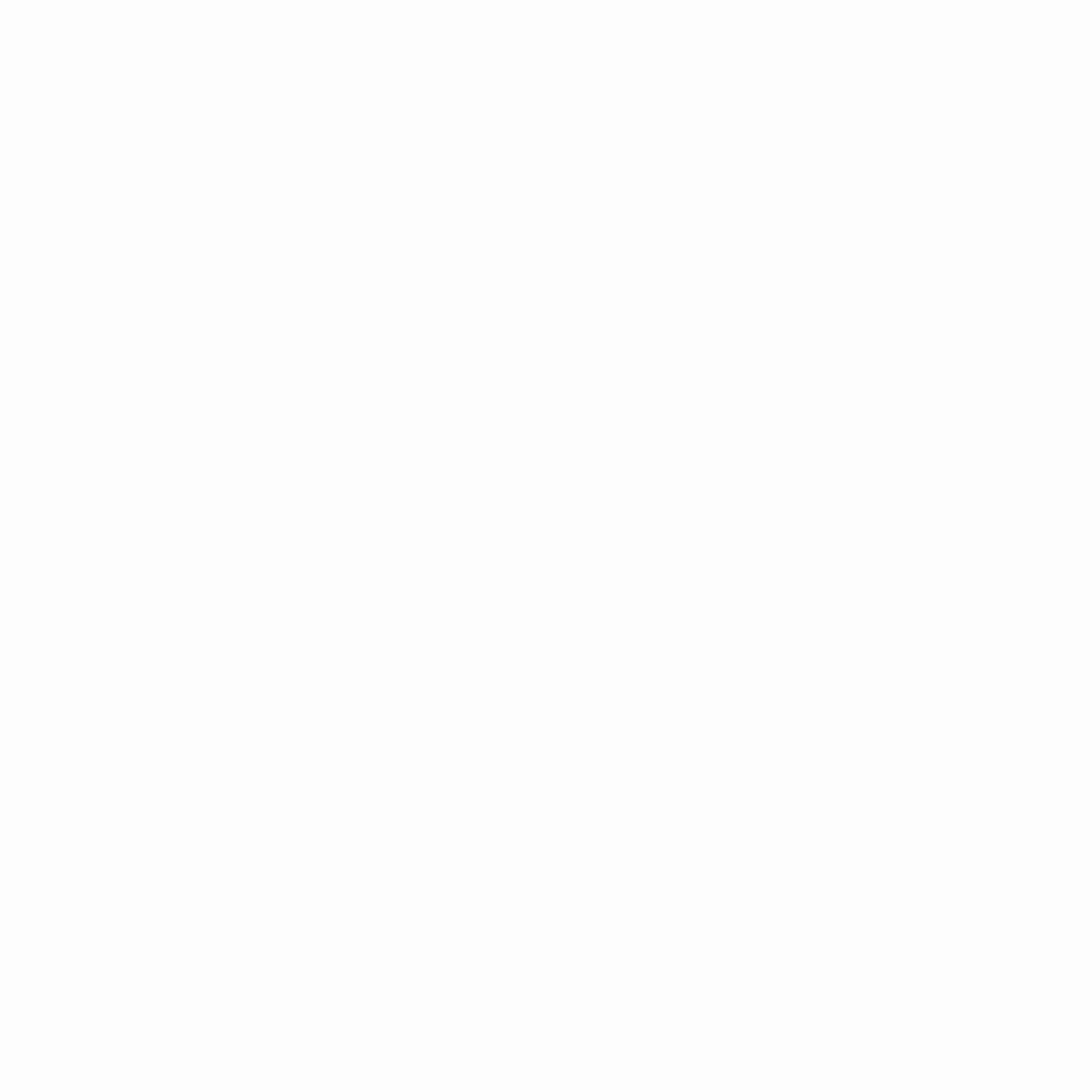حين بَلَغنا عمر الدراسة لم يكن في الكويت مدارس خاصة تقدّم نوعاً من التعليم الديني، أو عناية خاصة باللغة العربية (وكانت المدارس الخاصة المعروفة حينها هي المدارس الأجنبية)، فألحقنا والدي بمدرسة خاصة خيرية (أنشأتها جمعية كويتية خيرية برسوم رمزية، للوافدين، بصورة أساسية). تعتني المدرسة بالتربية الإسلامية، وتعطي دروس التجويد (مادة اختيارية بديلاً عن دروس الموسيقا)، وتدرّس اللغة الإنجليزية في الابتدائية.
كان عدد الطالبات في الفصل يتراوح بين 33 إلى 38 طالبة، من جنسيات مختلفة، جُلّها المصرية والفلسطينية. وكانت المعلمات كذلك، كنّا -في الصف المكتظ- نسمع لهجات متنوعة، وكانت لهجات الأبلات من نفس البلد تتفاوت تفاوتاً أكثر من الفرق “الياء” و”الجيم”- في لهجتنا-، على نحو يجعل طفلاً يُرخي سمعه يدرك أن اللهجات جغرافية تتأبى على حدود الأقطار، وأن القاف في فلسطين لا تُنطق همزة في كل مكان، وأن الجيم “القاهرية” تُسمع في الشام، كما الجيم “العراقية” في شمال إفريقيا.
كانت المعلمات يدرّسن “بضمير”، كأن الشهادة ضرورة من ضرورات الحياة وقوتاً من أقواتها. فالدفتر هو المعادل الموضوعي للخبز؛ تماماً كما في بيت محمود درويش: “أسُلُّ لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر”، وكانت لهذا نتيجة: أن المدرسة تُخرّج أوائل الثانوية العامة على مستوى الكويت في كل عام، (وقد رأيت حزن الأمهات -على أبواب المدرسة- عند إعلان نتائج الثانوية العامة، إذا حصلت ابنة إحداهن نسبة امتياز “غير مرتفعة”).
وكانت طريقة جُل المعلمات في الشرح: الإعادة والتكرار في شرح القاعدة، أو النص، أو خطوات الحل على نحو يجعلنا نحفظ الدرس، فلا نعود نستغرق فيه وقتاً طويلاً عشية الاختبار. وكان متوسط المعدّلات مرتفعاً، حتى إنك إن حصلت على نسبة 95% يقع ترتيبك في ذيل قائمة الأوائل العشرة في صفّك.
كانت معنا طفلة يمنية تتولى تدريس إخوتها الأصغر سنّاً ومتابعتهم، لأن الأم (الشابة) لا تعرف القراءة والكتابة، والأب نصيبه منهما فكّ الخط.
في (الهدّة)، كنا نرى طفلة تعلب مع أخواتها “لعبة المدرسة”، في زاوية الساحة، تصفُّهم كما في فصل، وتكتب بالطباشير على الأبواب الخشبية، لينهوا حل واجباتهم قبل أن يأتي والدهم من عمله ليستلمهم قُبيل العصر.
أتى أبي ليأخذنا -يوماً- من المدرسة، وفي انتظاره لخروجنا أتت طفلة في الابتدائية بظفيرتين، قفزت بحب في وجه والدها تسلّم عليه: أهلا يا بابا، فصفعها على وجهها (على تأخُّرها في الخروج)، ولم يَبْد أن الطفلة قد تأثرث لذلك، غير أن أبي -الذي تجهّم وجهه- نَهَره: تأتيك تسلّم عليك فتصفعها؟! وقد زادت ردة فعل أبي مِن فَزَعي من الموقف، ونفوري منه.
وكان أبي بعض الأوقات يأخذ معنا ابنة أحد معارفه، يقع بيتهم في طريقنا، فيوصِلها -لأن والدها يتأخر عمله في الشركة-، وأحياناً تكون معنا في زيارتنا لبيت جدتي -بعد نهاية الدوام-. كانت جدتي توزّع علينا حلوى أو علك، فتقسم الطفلة -ذات السابعة- حلواها نصفين، تخبَّئ في جيبها الأيسر نصفها لأخيها في البيت.
كيف لطفلة أن تمنع نفسها عن شطر نصيبها من الحلوى، لأخ لم يعرف أنها نالتها؟ ولِمَ لم تأكلها مكتملة؟
كانت أمي تضع في حقائب طعامنا لوجبة الفرصة حلوى (أولكر) -التي تحتوي الوِحدة الواحدة منها على ستة قطع صغيرة مغلّفة-:
“خذي وحدة ووزعي على رفيجاتك”.
فهي تأتمنك على “هذا الكم” من الحلوى -من جهة-، وتعلِّمك أن تعطي مما في يدك، بممارسة يومية متكررة.
كانت إحدى الطالبات في الفصل تُعلق مفتاح الشقة في خيط مثل قلادة تحت ملابسها، لأنها (وإخوتها الأصغر) يعودون مع الباص، قبل عودة والديهم من أعمالهم، وتجهز -أحياناًالأطباق على السفرة أو تشعل نار الفرن -التي لا نَقربُها-.
في الفرصة كنا نرى أطعمة متنوعة، بروائح مختلفة، مغلّفة بأكياس (شركة المطاحن) مُعاد تدويرها، كانت طيبة، ولم نكن نستكره شيئاً منها، حتى أدركنا في مرحلة لاحقة التمايز في الطعام بوصفه موقف تمييز طبقيّ، يصبّ في أوعية البلاستك وجيوب الشركات.
وكنا نرى كيف يبتكر طفلاً أسباب الرزق دون أن يحطّ من قَدْر نفسه وعائلته: كانت عند البنات لعبة دارجة: لوحة تُحاك بخيوط صوف قصيرة وسنارة (تستخدم لاحقاً وسادة زينة)- تحب البنات أن تُكملن اللوحة لكنهن يتباطأن حتى تبقى اللوحة فصلاً دراسياً لا تكتمل- فتعرض طفلة أن تكملها في إجازة نهاية الأسبوع، لمن يحب، بأجر معقول.
كانت المعلمة السورية تشرح أبياتاً من قصيدة -لخير الدين الزركلي (ت 139هـ)- يقول في بيت منها (تُصُرّف فيه في المنهج المقرر):
أذْكَرتني ما لستُ ناسيه ولرُبَّ ذكرى جددت حَزَنا
أَذْكرتَني وطني وواديه والطير آحادٌ به وثُنى
ثم تستدرك إلى النص الأصلي، تقول أنها تمنّت لو لم يُتَصرَّف فيه:
أَذْكرتَني (بَردَى) وواديه والطير آحادٌ به وثُنى
تحكي لنا كم جميل نهر بَردى، وأن الوادي يُنسب إليه -في القصيدة- لا للوطن: “وواديه”. وليس في كتابنا المقرر صورة للنهر، ولا بين أيدينا محرّك بحث، فتتولد صور خضراء في خيال طفل خَصب، من بلد صحراوي اعتادت عيناه اللون الأزرق والبنايات.
كانت المعلمة تتحدث بحب بالغ عن بُردى (يُذكِّرك -في عُمُر لاحق- بحديث الطنطاوي في مذكراته عن قاسيون)، وبلد لا يبدو قريباً منها، ولا يبدو أنها غادرته قريباً.
– لماذا يشتاق الناس لأوطانهم؟
– لأنهم غادروها.
– ولماذا لا يعودون إليها ماداموا يشتاقون؟
ويبقى السؤال، وجُلّ من في المدرسة غرباء أو لاجئون، تتبّه لاحقاً أن ليس في حديث الأطفال أسرة ممتدة، أو زيارات عائلية، وبنات خال وبنات عم، وأن جل الحديث عن نزهات في نهاية الأسبوع على البحر أو في الحديقة، وأصدقاء من زملاء العمل أكثر من الأقارب، ومجتمعات قديمة في الكويت، لكن لا وطن.
تشرح معلمة النصوص -الفلسطينية السمراء ذات البشرة الداكنة- (للصف الثاني أو الثالث الابتدائي) قصيدة :
وقف الأسير مقيّدا بين الأَسنّة والعــــدا
وإذا تلفّتَ حولـــه وجد السلاح مُسدَّدا
وأنت لا تعرف ما (الأسير) لأنك لا تعرف ما الحرب، وتشرح الأبلة (المحروق قلبها) مشاهد من انتفاضة (أطفال الحجارة) إذْ ذاك، تخبرك عن آليات العدو الإسرائيلي كيف تواجهها الصدور العارية، عن الجراح، عن المصابين، ويكون هذا لك فوق طاقة طفل لم يبلغ السابعة، فتجعل راحة كفّك على أذنك، لتحجب صوتها، فلا يكفي ذلك لحجب الصوت الذي يتسلل من الأذن الأخرى ، فتضع كفّك الثانية على الأذن اليسرى، تنتبه المعلمة لاضطرابك ولا تنتبه لسببه:
– مالك يا حصة؟ إذنك بتوجعك؟
– ها؟ إي إي، اثنينهم يعوروني.
وتكمل المدرسة وصفها للمشاهد، ويعلو نصَّ القصيدة في الكتاب صورة مرسومة لأسير عاري الصدر، يلفُّ وجهه بكوفية، مادّ ذراعيه المقيدتين، وجندي محتل يسدد فوهة بندقيته نحوه.
وتشرح أبلة الاجتماعيات (السورية) جزءاً من الخريطة، ثم تشير -عَرَضاً- إلى فلسطين، وتقول وهي تهمّ أن تطويها: “وطني السليب”. وفي يوم درس (البيئة البحرية في الكويت) تطبخ المعلمة للمدرسة (مطبّق سمك)، ويأتي يوم آخر وتدور بـ (المسخّن).
كم وِجهةٍ يشير إليها المرء إذا قال: “وطني”؟
وإلى أين يسافر في الإجازة ليلتقي أهله؟
وماذا يطبخون -إذا ما التقوا- في أعيادهم؟
وتسمع أنشودة (سأل الطفل الحائر شادي) -تتكرر على مسامعك- فتعرف كيف لأطفال أن تكون لهم أوطان لم يروها، يحفظون أسماءها يحفظون أسماء أحيائها، وقصة نزوح الجدّ عنها، لكنهم لم يلعبوا في حواريها، ولم يدرسوا في مدارسها، وصِلَتُهم بها الخارطةُ، مُعلّقة في الدار. لكنك تعرف أن هذه الأوطان غداً ستعود، تَعِدُك الأنشودة بذلك، ويَعِدُك الأطفال كذلك.
لا أذكر -ولا تذكر صاحباتي- مشهداً يتطلع فيه الأطفال إلى ما بين أيدينا من الأشياء، كُنَّ -فيما يبدو- يعرفن أنهن بلا وطن، ولا تبدو الأشياء بعد الوطن مهمة.
في وقت معين لاحق تراجع مستوى المدرسة لأسباب إدارية تتعلق بعدم وجود مديرة، فقررت عمتي (المديرة المتقاعدة) أن ترجع إلى العمل وتدير المدرسة؛ وفعلت ذلك احتساباً، فهي لم تكن ترغب بالعودة إلى الوظيفة.
كانت على صلة طيبة بالمعلمات، تقضي حاجات لهن -ما استطاعت إلى ذلك سبيلا-، تجمعهن عندها في المنزل تكريماً لهن بعد جهد مبذول في نشاط كبير، في احتفالية منزلية تعرف أن تكريم الغريب هو إيواءه إلى الدار.
كنا نحضر أسواقاً خيرية ومناشط أخرى تقيمها الجمعيات والمؤسسات، يعطوننا حصالة على شكل مجسم، تجسِّد صورة خيمة وبئر (في آسيا الوسطى)، وعلى الصور المعلّقة وجوه أطفال آخرين، ألوانهم مختلفة وثيابهم مختلفة. وتأخذ الحصالة وكأنك تأخذ قطعة من (بيت) طفل آخر إلى بيتك، بيتٌ مختلف تماماً، لا يقي من البرد ولا يكاد يستر في الحر، ثلاجته بئر، غير أنك بإمكانك أن تمدّه بشيء.
أعطتنا الكويتُ كثيراً حين أعطتنا فرص الاختلاط والانخراط هذه، أعطتنا الكثير الكثير في مهاراتنا الاجتماعية ومعارفنا النفسية، وقيمنا الدينية، وتصوراتنا عن رابطتنا كأمة، وفي انكشافنا على حيوات أخرى.
يقول د. غسان أبو ستة عن طفولته في الكويت: “طفولة الكويت؛ الكويت هيأت المناخ للأربعمية ألف فلسطيني اللي عاشوا فيها للتعبير عن الهوية الفلسطينية، أكثر من، -أنا برأيي-، أكثر من أي مكان آخر. لم يكن هناك أي ضوابط على التعبير عن الهوية الفلسطينية للفلسطينيين في الكويت”.
وفي الغزو، حين نزحنا إلى السعودية، رأينا بلداً كبيراً كبيراً، تسافر فيه -لا منه-. وأناس لا نعرفهم يفتحون لنا بيوتهم، ولهجات كثيرة في مدرسة (250) في الإسكان في (حي المعذر)، وألوان وأنماط شَعر مختلفة، وبلد لِسعته لا يعرف بعض أفراد الجنوب أسماء أحياء الشمال، ولكثير من الأطفال بيتان: بيت العائلة في(الديرة)، وبيت في المدينة حيث يعمل الأب (وأنت تعرف أن “الديرة” هي العاصمة، وإذا “الديرة” هي القرية).
ومعلمات يحببننا ولكننا نجتهد في فك أصوات لهجاتهن، وأخريات يشبهننا في ملامحنا وفي لهجات أقاربنا. وشوارع حية، أعمال كثيرة، فيها رجل الأعمال وفيها بائع السواك. بلد كبير أشبه بقبيلة كل من فيها رحمٌ، تسوده قيم أصيلة، تطهّره من كثير من زيف المدينة ووعثائها!
(في هذا المقطع تتحدث أديبة روميرو عما منحتها إياه تجربة طفولتها وصباها في مكة.)
تتعلم من هذه التجارب، فيما تتعلمه، تفاوت أطباع الناس، واختلاف صورها ومعانيها، فليست كل قسوة متعمّدة، وليست المحبة ظاهرة دائماً، في كل تعاطٍ معنى يضمره صاحبه أو يبديه، وحساسية وعيك بحقيقة اختلاف النفوس وتنوع النوازع يعينك على تلمّس معرفة ووعي لست تجده في الكتب، ولا تمنحك إياه إلا تجارب التعايش.
زاوية:
“إلى طفلةٍ في الدار تسأل أمها:
أَحقاً إذا مرَّ الزمان سنَكبرُ”
لـ عبداللطيف بن يوسف