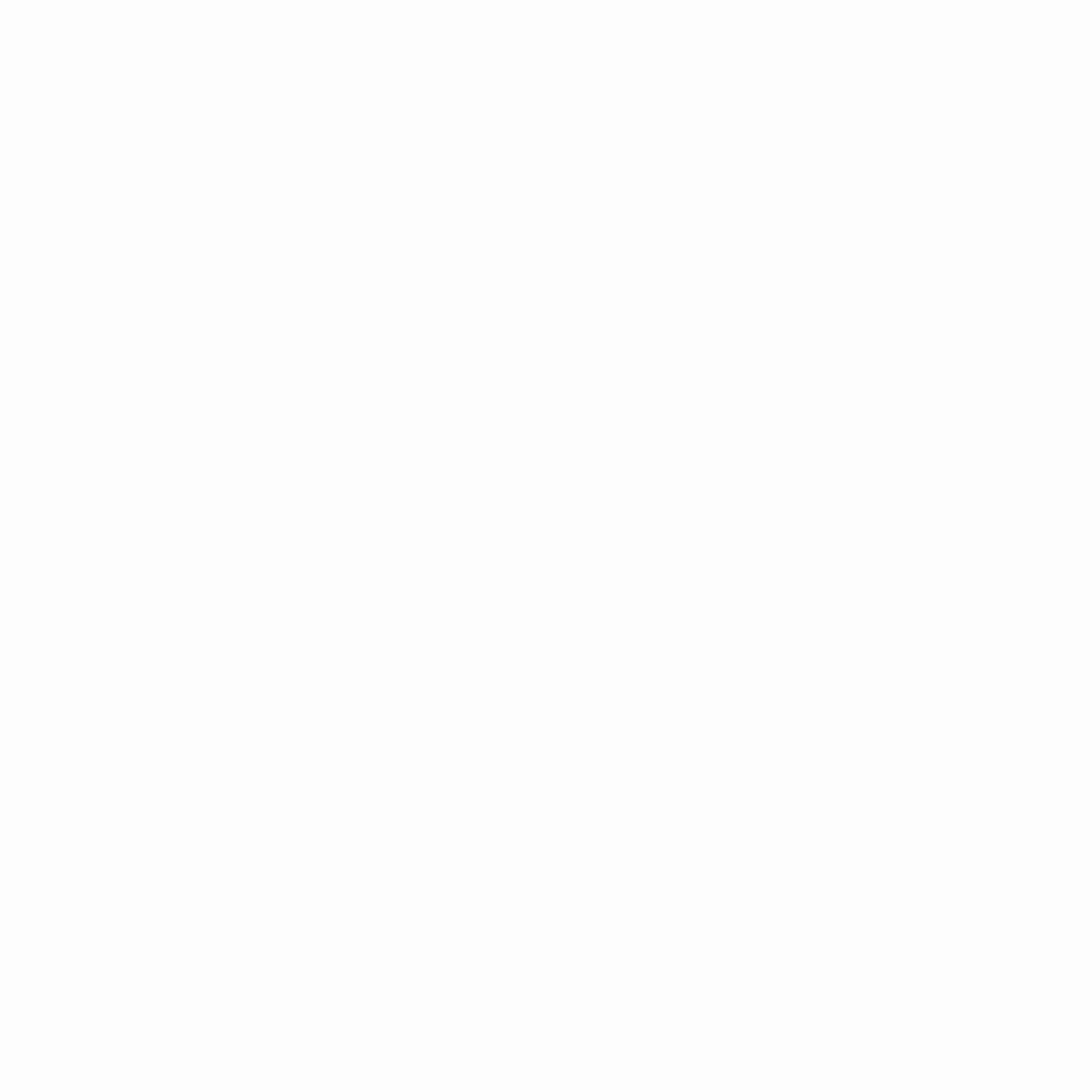كنت أداوي العزلة بالتواصل.
في مارس، عندما بدأت الحياة تعود شيئاً فشيئاً إلى طبيعتها، أرسلتُ إلى ساره:
– سارون، أبي أتطوع معاكم، عطوني شي أسويه.
كنت أتوقع تكليفاً بعملٍ مكتبيّ، يتعلق، مثلا، بالتخطيط لمشاريع، أوصياغة أفكار، أو تطوير مواد.
– هلا حصة، الحين ما عندنا شي من هذا، بإمكانك أن تقدمي مشروعاً وتقومي على إنجازه.
ولم أكن على طاقة تتيح لي أن أبتكر مشاريع، كنت أهدف إلى عمل مكوّن مهام صغيرة، يتيح لي التواصل والعطاء.
– سارون حالياً ما عندي مشروع، ولا أظن أني بإمكاني أن أقدم شيئاً مما تطلبون، بس ودي أسوي شي، على قدر طاقتي ..
لحظة ! أقدر أقدم شي، تبون دورة لغة عربية؟ نحو وقواعد الكتابة.
وكأنما قد اقترحت لها واحداً من المشاريع المنتظَرة.
– ييتي ويابك الله، احنا نبي نطور مهارة الكتابة، ونقلل الأخطاء الإملائية واللغوية عندنا.
أربعة أيام، اثنتا عشرة ساعة، في قاعة تدريبٍ مُتحلّقة – وليس من وراء شاشة. واستراحة في مكاتب البنات، من كعك وضحك، أصوات حية متداخلة، وسوالف تتقاطع ولا تكتمل.
وبعد ختام الدورة ببضع شهور، وصلني إيميل من مكتب التدريب في الجمعية يطلبون فيه “إقامة دورة في اللغة العربية للعاملين في الميدان”، أي: لموظفيهم في إفريقيا. و كان موعد الدورة بعد شهور من الرسالة، وفي الترتيب للدورة، تواصلت مع المنظّم في مكتب التدريب في الكويت، وقبل أن أفرغ من إملاء اشتراطاتي وملاحظاتي، قال: – أختي، أختي .. أنتِ تدربين في إفريقيا، انسي كل ما تعرفينه عن التدريب في الكويت.إنهم حريصون على التعلم حرصاً شديداً، حتى أن أحدهم ليحضر المحاضرة وهو في مزرعته، أو في طريقه إلى مدرسة أطفاله، أو في المصنع أو في الحقل، أو على ظهر دابة. كتمت ضحكي، وانتهت المكالمة، ولم أكمل اشتراطاتي.
أرسلتُ استمارة للمشاركين، فيها أسئلة تقيس مستوى معرفة اللغة، وأسئلة للتعرف على المشاركين، وأسئلة (كسر الحاجز النفسي). – كيف مرّت كورونا؟ ما أجمل ما كان في الثمانية عشر شهراً الماضية؟ وما هو أصعب ما كان فيها؟ وجاءت بعض الإجابات أن أصعب ما كان فيها: أيامٌ مرّت بلا قوت، أوعامٌ بلا عائلة.
مرّ يوم الدورة الأول، أطبقتُ شاشة (اللابتوب) على لوحة المفاتيح، وبكيت. بكيت فرحهم بالدرس وشدة حرصهم عليه، بكيت ثغاء الماعز يصلك صوته في الصف، بكيت خضرة إفريقيا تظهر لك من وراء الشاشات السوداء المعتمة. بكيت أطفالاً متراصين في المقعد الخلفي، من سيارة لا نوافذ لها، ظهروا في شاشة أبيهم في بداية الدرس، قبل أن يطلب منه أن يغلق الشاشة.
قلت لهم، على هامش الدروس، أن إفريقيا قد أعطت الكويت الكثيرَ إذْ أعطتها الكويتُ. وأن إفريقيا قد اختلطت بذاكرة الشعور: ثوب مدرسة يشبه ثيابنا، ترتديه طفلة إفريقية تضحك لنا (صورتها مطبوعة على ظهر جداولنا المدرسية). أو عيداً نخبئه في جيبين، أوحلوى نقسمها بين طفلين. أو صندوقاً عليه دمعة طفل، تكفّر به الجدة عن نذورها إذا توعدّتنا ولم توفِ وعيدها، يعلّمنا الصندوق أن بوسع أناملنا الصغيرة أن تمسح الدمعة عن خد المسكين. وقلتُ لهم أن السواد، عند العربي، هو الخضرة اليانعة، وأن القارة السوداء هي الخضراء، في عين الرحالة العرب الذين زاروها. وأن من يعمل فإنما يعمل لنفسه، وأنّا نأخذ حين نُعطي.
أربعة أيام، اثنتا عشرة ساعة، في قاعة تدريبٍ مُتحلّقة – وليس من وراء شاشة. واستراحة في مكاتب البنات، من كعك وضحك، أصوات حية متداخلة، وسوالف تتقاطع ولا تكتمل.
وبعد ختام الدورة ببضع شهور، وصلني إيميل من مكتب التدريب في الجمعية يطلبون فيه “إقامة دورة في اللغة العربية للعاملين في الميدان”، أي: لموظفيهم في إفريقيا. و كان موعد الدورة بعد شهور من الرسالة، وفي الترتيب للدورة، تواصلت مع المنظّم في مكتب التدريب في الكويت، وقبل أن أفرغ من إملاء اشتراطاتي وملاحظاتي، قال: – أختي، أختي .. أنتِ تدربين في إفريقيا، انسي كل ما تعرفينه عن التدريب في الكويت.إنهم حريصون على التعلم حرصاً شديداً، حتى أن أحدهم ليحضر المحاضرة وهو في مزرعته، أو في طريقه إلى مدرسة أطفاله، أو في المصنع أو في الحقل، أو على ظهر دابة. كتمت ضحكي، وانتهت المكالمة، ولم أكمل اشتراطاتي.
أرسلتُ استمارة للمشاركين، فيها أسئلة تقيس مستوى معرفة اللغة، وأسئلة للتعرف على المشاركين، وأسئلة (كسر الحاجز النفسي). – كيف مرّت كورونا؟ ما أجمل ما كان في الثمانية عشر شهراً الماضية؟ وما هو أصعب ما كان فيها؟ وجاءت بعض الإجابات أن أصعب ما كان فيها: أيامٌ مرّت بلا قوت، أوعامٌ بلا عائلة.
مرّ يوم الدورة الأول، أطبقتُ شاشة (اللابتوب) على لوحة المفاتيح، وبكيت. بكيت فرحهم بالدرس وشدة حرصهم عليه، بكيت ثغاء الماعز يصلك صوته في الصف، بكيت خضرة إفريقيا تظهر لك من وراء الشاشات السوداء المعتمة. بكيت أطفالاً متراصين في المقعد الخلفي، من سيارة لا نوافذ لها، ظهروا في شاشة أبيهم في بداية الدرس، قبل أن يطلب منه أن يغلق الشاشة.
قلت لهم، على هامش الدروس، أن إفريقيا قد أعطت الكويت الكثيرَ إذْ أعطتها الكويتُ. وأن إفريقيا قد اختلطت بذاكرة الشعور: ثوب مدرسة يشبه ثيابنا، ترتديه طفلة إفريقية تضحك لنا (صورتها مطبوعة على ظهر جداولنا المدرسية). أو عيداً نخبئه في جيبين، أوحلوى نقسمها بين طفلين. أو صندوقاً عليه دمعة طفل، تكفّر به الجدة عن نذورها إذا توعدّتنا ولم توفِ وعيدها، يعلّمنا الصندوق أن بوسع أناملنا الصغيرة أن تمسح الدمعة عن خد المسكين. وقلتُ لهم أن السواد، عند العربي، هو الخضرة اليانعة، وأن القارة السوداء هي الخضراء، في عين الرحالة العرب الذين زاروها. وأن من يعمل فإنما يعمل لنفسه، وأنّا نأخذ حين نُعطي.
هامش: عن الألوان عند العرب.