أما قبل:
فلا تقدم هذه التدوينة تأويلاً لمعنى الآية (سوى ما نُقل من أقوال المفسرين)، وهي إذ لا تفعل ذلك، فليست تقدم تأملاً في معناها نفسه، وإنما تأملات في فعل التواصل، وفي العجز فيه، في البيوت الآمنة.
في أقوال المفسرين:
ترد في التفاسير في معنى هذه الآية أقوال[1] يقولها المفسرون تشّق عليك، ثم تنظر فتجد أنها تُردّ إلى قول يتناقلونه عن قتادة (ت 680 هـ) -التابعي الجليل، مفاده ضعف الحجة والعجز عنها بالأنوثة[2]، حتى قال ابن عاشور (1393 هـ):
وعلى هذا التفسير درج جميع المفسرين.
غير أن ابن عاشور حين نقل هذا، علّق عليه بعبارة مُحْكَمة فيها معنى التقييد بالمتعارف من جهة، وفيها إحالة إلى منطِق المُحاجَج، من جهة أخرى. قال:
والنَّشْءُ في الحلية كناية عن الضعف عن مزاولة الصعاب بحسب الملازمة العُرفية فيه. والمعنى أن لا فائدة في اتخاذ الله بنات لا غناء لهن فلا يحصل له باتخاذها زيادة عِزّة، بناء على متعارفهم، فهذا احتجاج إقناعي خطابي.
ثم هو يورد قوله في تفسير الآية: فيجعل الخصام بمعنى القتال، وعدم الإبانة هي الهزيمة فيه، ثم يحيل إلى قول المشركين في الإناث، متخذاً من ذلك دليلاً عدم إعمال المشركين الفِكر في معتقداتهم. فكأنه يجعل القول باستضعاف الإناث مقولاً عنهم، لا عن النص القرآني، ناشئاً عن متعارَفهم لا مُتعارَف هذه الأمة، يقول:
ويجوز عندي أن يحمل الخصامُ على التقاتل والدّفاع باليد فإن الخصم يطلق على المُحارب، قال تعالى: “هذان خصمان اختصموا في ربّهم”. فُسِّر بأنهم نفر من المسلمين مع نفر من المشركين تقاتلوا يوم بدر. فمعنى: “غير مبين” غيرُ محقق النصر. قال بعض العرب وقد بُشر بولادة بنت «والله ما هي بِنِعْمَ الولدُ بزُّها بكاء ونصرها سرقة».والمقصود من هذا فضح معتقدهم الباطل وأنهم لا يحسنون إعمال الفكر في معتقداتهم وإلا لكانوا حين جعلوا لله بنوة أن لا يجعلوا له بنوة الإناث وهم يُعدّون الإناث مكروهات مستضعفات.
كأنه بإيراد هذه الأوجه يحاول أن يتحايد إطلاق قولٍ “درج عليه جميع المفسرين”. وأنت بين يديك من التاريخ والسيرة ما يثبت خلافه.
أما بعد:
تعرف مجالس التقاضي ومجالس الإصلاح بيان للمرأة عن حجتها، تُبين في منازعات تتعلق بدفاعها عن أسرتها، أومنازعتها حقوقها، تحاجّ مُحاجّة تستوفي بها ما يقوم به أمر نفسها أو أمر بيتها، يُشاهد هذا، ويشهده من جلَس حكماً أو قاضياً، في مجالس قد يسكت فيها القاضي، أو يصمت الحَكمان، وهي تُسمعهم حجتها، أو قد يُطرق فيها الزوج (أو المخطئ) رأسه -إذا هو يريد الحق والإصلاح-. وقد كانت قبلُ تجادل النبي -صلى الله عليه وسلم- في زوجها، و تجادل عمر -رضي الله عنه- في بعض أمرها ، ثم تصير المجادلة من أسباب النزول.
غير أن مقام التواصل في البيوت الآمنة غير مقام التواصل في مجالس الاحتكام، والقصد الذي نريده من هذا أن دور اللغة في مواقف الوصل، غير دور اللغة في مجالات الحِجاج. (أذكر أن مغردة اسمها عاج كتبت مرة: أن الإنسان ابتكر اللغة ساعة فراق، ثم نسيها ساعة وصل).
لا تُبين: فقد لا تكشف لغتها عن مكنوناتها ساعة الخصام لأسباب عدة: تغلبها عَبرة، أو تأخذها شكوى، أو يلهيها عتاب عن منطق. أو لا تُبين: لأنها لا تحمل هم الإبانة، متكئة على الدين والرحمة، أو على العدل والمروءة، لا على آلة اللغة، في استيفائها مطلوباتها.
وفي البيوت مشكلات تواصلية، ولابد. وقد لا تبين البنت ساعة الغضب أو الخصام، وفي التبيُّن لمن أراد أن يتبيَّن لابد صبر. وفي هدي النبي أحاديث تنص على فضل تربية البنات، يرد لفظ (الصبر) في بعضها، ويكون متعلقاً بهن، لا برزقهن: “فصبر عليهن”، ولم يقل: صبر على إطعامهن أوعلى كسوتهن – مثلاً:
من كانَ لَهُ ثلاثُ بَناتٍ فصبَرَ عليهنَّ ، وأطعمَهُنَّ ، وسقاهنَّ ، وَكَساهنَّ من جِدتِهِ كنَّ لَهُ حجابًا منَ النَّارِ يومَ القيامةِ.
فهل يكون في معنى (الصبر عليها) أنه قد يتكلف السعي في رعاية احتياجات باطنة لها قد لا يراها هو ضرورات، أو لا يتبين له سبيل تلبيتها، ولكنه يصبر، ويتكلف تأديتها، وفي رأسه من ضرورات الكسب ألف ضرورة غيرها؟. والثمن في ذلك: الجنة.
هوامش:
[1] منهم من جعل ضعف الحجة في الخصام مسندة إلى المرأة، ومنهم من جعلها إلى الأصنام، “وعن ابن زيد أن المراد بمن ينشأ في الحلية الأصنام وتعقب بأنه يبعد هذا القول … إلا إن أريد بنفي الإبانة نفي الخصام أي لا يكون منها خصام” (الألوسي).
قلت: ولا أدري كيف “يُنشّأ” الحجر، والتنشئة طورٌ وإنما الأطوار متعلقة بمعنى الحياة في الأشياء.
[2] في تفسير الجلالين لهذه الآية: “لضعفه عنها [أي الحجة] بالأنوثة”.
هامش عن العنوان:
(لغة اللغة) هي الترجمة التي اختارها أ.د. محمد حلمي هليل، أستاذ الترجمة والمصطلحية، -رحمه الله- مكافئاً لـ metalanguge، وقال إن أ.د. سعد مصلوح صفّق حين سمعها منه أول مرة.
غير أن هذه التدوينة ليست تستعمل التعبير بمفهومه الاصطلاحي الدقيق.
كتتبتُ نصف هذه المقالة -في دفتر ملاحظاتي- في أزقة سفر، عام اغتراب، اكتشفتُ فيما بعد أنه كان قد أعطبَ شيئاً في روحي -دون أن أنتبه-، وكنت أسير في الطريق المرصوف حَجراً، وأنا أحسب أني إن مددتُ اللغة إلى بيتنا -عبر الهاتف- ستؤويني.
ثم إني لأعجب من لُطف الأقدار وعنايتها: كيف أنبتت هاتيك الدروب التي كان فيها وحشة، معاني أُنس، ثم كيف انفتقت تلك الطرق الحجرية -بعد أن أَغبرت قدماي- عن أبواب لم تكن في حسبان الطريق.
ربّ يسّر وأعن.
التدوينة القادمة ستكون: (“الجود يُفقر والإقدام قتّالُ”، عن تكاليف حُسن الخُلق: هل الأخلاق مُكْلِفةٌ حقاً؟). إن شاء الله-.
أقول هذا لأُُلزم نفسي، فعُودوا يا أعزاء، التزمنا هذا أم لم نلتزمه.


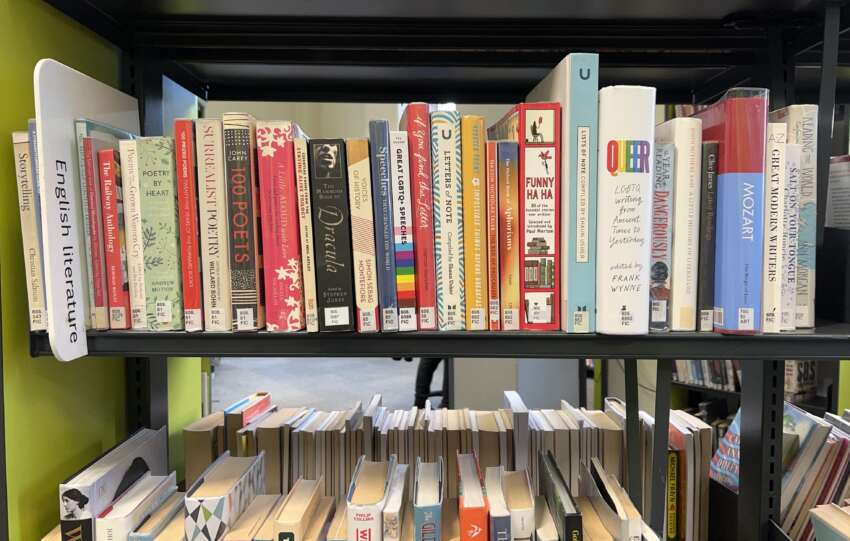
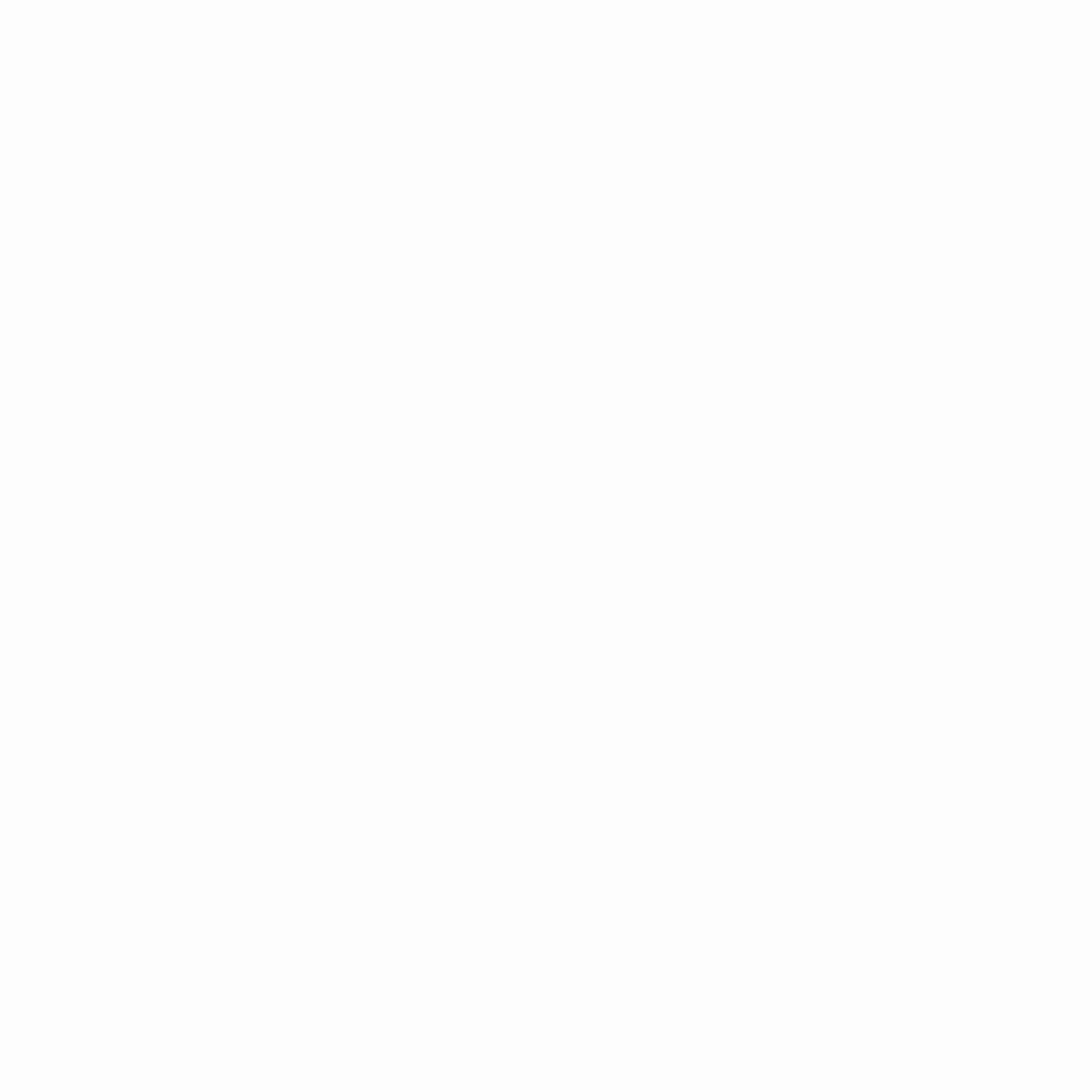
2 من التعليقات
غير معروف
إنا- وبكل شوق – لمنتظرون .
سعاد
تدوينة مبدعة
عورت قلبي الغربة التي اعطبت شي من الروح